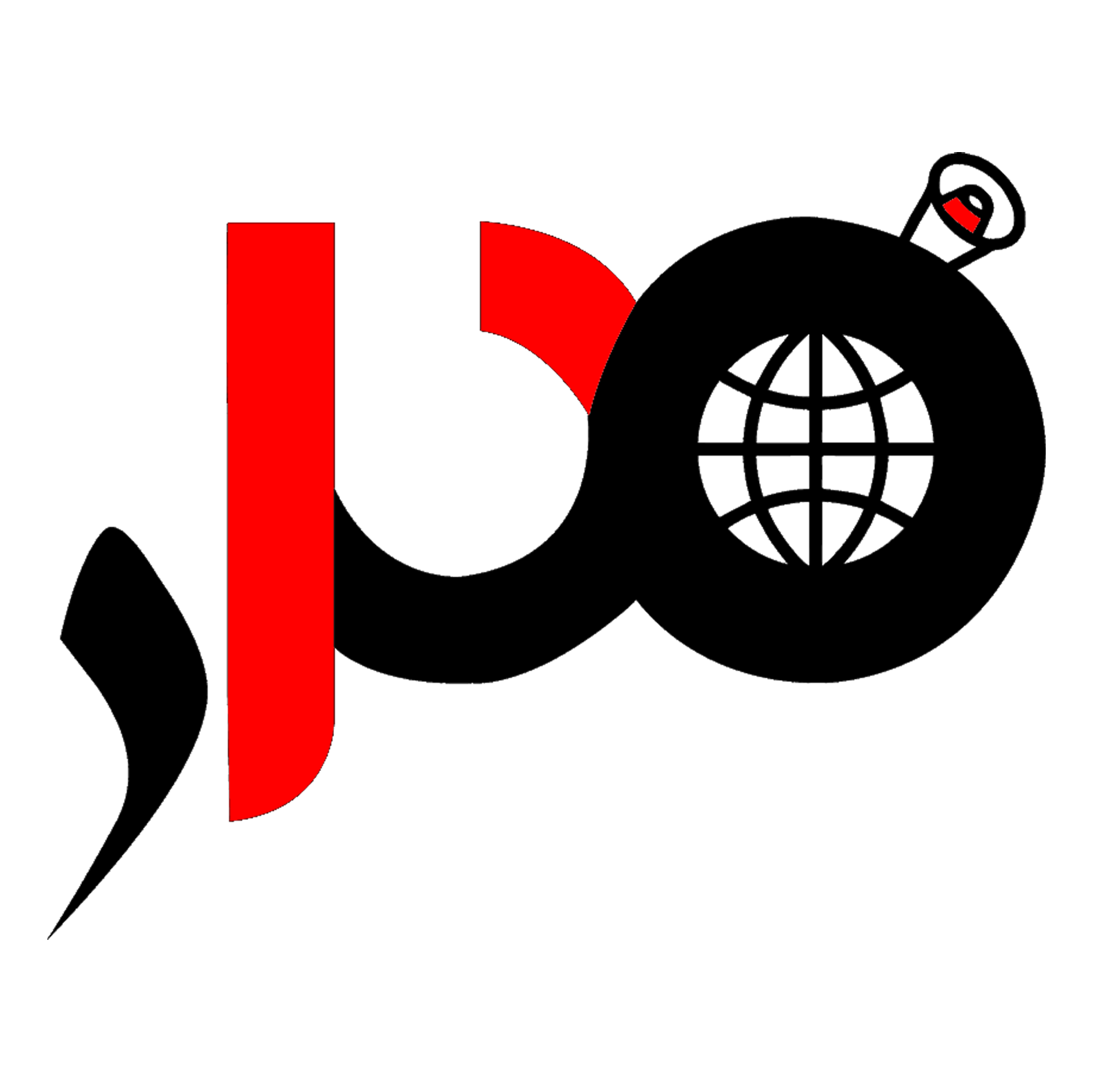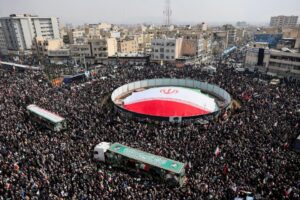معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي/ مدار: 11 غشت/ آب 2022
فيجاي براشاد*

حبس الناس في جميع أنحاء العالم أنفاسهم عندما وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى مدينة تايبي في تايوان، فقد كانت زيارتها عملاً استفزازياً.
يُذكر أن الحكومة الأمريكية اعترفت في ديسمبر/ كانون أول 1987 بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1971، وألغت جانباً التزاماتها التعاهدية السابقة تجاه تايوان. ورغم ذلك، وقع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر قانون العلاقات مع تايوان (1979)، الذي سمح للمسؤولين الأمريكيين بالحفاظ على اتصال وثيق معها، بما يشمل بيع الأسلحة. لقد كان هذا القرار جديراً بالملاحظة لأن تايوان كانت تخضع لقانون الأحكام العسكرية من 1949 حتى 1987، وهو الأمر الذي تطلب مورداً منتظماً للأسلحة.
لقد كانت زيارة بيلوسي إلى تايوان جزءاً من الاستفزازات الأمريكية المستمرة للصين، التي تشمل خطة الرئيس الأسبق باراك اوباما “الاستدارة نحو أسيا”، و”الحرب التجارية” للرئيس السابق دونالد ترامب، وإنشاء الشراكات الأمنية: الكواد (الرباعية)، واوكوس، والتحول التدريجي للناتو إلى أداة ضد الصين. وتستمر هذه الأجندة مع تقييم جو بادين الذي يشير إلى ضرورة إضعاف الصين لأنها “المنافس الوحيد المحتمل القادر على الجمع بين القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية وتشكيل تحدٍ مستدام” للنظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
لم تستخدم الصين قوتها العسكرية لمنع بيلوسي وقادة الكونغرس الأمريكي الآخرين من السفر إلى تايوان، ولكن عندما غادروا، أعلنت الحكومة الصينية أنها ستوقف ثمانية مجالات رئيسية للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها إلغاء التبادلات العسكرية وتعليق التعاون المدني في مجموعة من القضايا، مثل تغير المناخ. لقد كان هذا ما أنجزته رحلة بيلوسي: المزيد من المواجهة، وتعاون أقل.
في الواقع، يتم تشويه سمعة أي شخص يدعم زيادة التعاون مع الصين في وسائل الإعلام الغربية، وكذلك في وسائل الإعلام المتحالفة مع الغرب من بلدان الجنوب باعتباره “عميلاً” للصين أو مروجاً لـ “المعلومات المضللة”. لقد أجبتُ عن بعض هذه المزاعم في صحيفة صنداي تايمز بجنوب إفريقيا في 7 أغسطس/ آب 2022. والجزء المتبقي من هذه المراسلة يعيد استحضار هذا المقال.

يتسلل جنون من نوع جديد إلى الخطاب السياسي العالمي، وهو تشوش من نوع سام يخنق العقل والمنطق، هذا التشوش الذي غمر منذ فترة طويلة الأفكار القديمة القبيحة عن تفوق البيض والتفوق الغربي يعيق أفكارنا عن الإنسانية. والمرض العام الذي ينجم عن ذلك هو شك عميق وكراهية للصين، ليس فقط لقيادتها الحالية أو حتى النظام السياسي الصيني، بل كراهية البلد بأكمله والحضارة الصينية – كراهية أي شيء له علاقة بالصين.
جعل هذا الجنون إجراء نقاش كالبالغين حول الصين مسألة مستحيلة، هذا ويتم إلقاء كلمات وعبارات مثل “سلطوي” و”إبادة جماعية” دون أي اهتمام بالتأكد من الحقائق. إن الصين بلد لـ 1.4 مليار إنسان، وهي حضارة عريقة، عانت كما غالبية الجنوب العالمي من قرن من الإذلال، وهذا نتيجة حروب الأفيون البريطانية التي بدأت عام 1839 وحتى الثورة الصينية في 1949، عندما أعلن الزعيم ماوتسي تونغ، عن وعي، أن الشعب الصيني وقف على قدميه. ومنذ ذلك الحين، شهد المجتمع الصيني تحولات عميقة عبر استخدام ثروته الاجتماعية لمعالجة المشاكل القديمة المتمثلة في الجوع والأمية واليأس والسلطة الأبوية. وكما هو الحال مع جميع التجارب الاجتماعية، كانت هناك مشاكل كبيرة، ولكن هذه مسألة متوقعة من أي عمل بشري جماعي، وبدلاً من رؤية نجاحات الصين وتناقضاتها، يسعى هذا الجنون في عصرنا إلى تحويل البلاد إلى كاريكاتير استشراقي – دولة استبدادية ذات أجندة إبادة جماعية تسعى إلى الهيمنة على العالم.
توجد لهذا الجنون نقطة منشأ محددة في الولايات المتحدة، حيث تتعرض النخب الحاكمة لتهديد كبير بسبب تقدم الشعب الصيني – لا سيما في مجال الروبوتات والاتصالات والسكك الحديدية عالية السرعة وتكنولوجيا الحاسوب. ويفرض هذا التقدم تهديداً وجودياً للامتيازات التي تمتعت بها طويلاً الشركات الغربية التي استفادت من قرون من الاستعمار وقيود قوانين الملكية الفكرية. لقد أدى خوف الغرب من هشاشته واندماج أوروبا في التطورات الاقتصادية الأوروبية الآسيوية إلى قيامه بشن حرب إعلامية ضد الصين.
إن هذه الموجة الأيديولوجية تغلب على قدرتنا على إجراء نقاشات جادة ومتوازنة حول دور الصين في العالم. إذ إن الدول الغربية التي تتمتع بتاريخ طويل من الاستعمار الوحشي في إفريقيا مثلاً تدين بشكل منتظم ما تسميه الاستعمار الصيني في إفريقيا، وذلك دون أدنى اعتراف بماضيها أو بالوجود العسكري الفرنسي والأمريكي الراسخ في جميع أنحاء القارة. ودائماً ما يتم توجيه اتهامات بـ”الإبادة الجماعية” لشعوب العالم ذوي البشرة الأكثر سماراً – سواء في دارفور أو في شينجيانغ – ولكنها لا توجه أبداً إلى الولايات المتحدة، التي أدت حربها غير الشرعية على العراق وحدها إلى مقتل أكثر من مليون شخص. إن المحكمة الجنائية الدولية، المنغمسة في المركزية الأوروبية، تدين زعيماً إفريقياً تلو الآخر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنها لم تدن أبداً زعيماً غربياً بتهمة حروبهم العدوانية التي لا نهاية لها.

يغلفنا ضباب هذه الحرب الباردة الجديدة اليوم. اتُهمت مؤخراً، في جريدتي ديلي مافريك ومايل آند جارديان ، بالترويج لـ “الدعاية الصينية والروسية”، وبأن لدي صلات وثيقة بدولة الحزب الصينية، ولكن ما هو أساس هذه الادعاءات؟.
أولاً، تحاول عناصر في المخابرات الغربية وصف أي معارضة ضد الهجوم الغربي على الصين بأنها معلومات مضللة ودعاية. على سبيل المثال، كشف تقريري في كانون الأول/ ديسمبر 2021 من أوغندا زيف الادعاء الكاذب بأن قرضاً صينياً للبلاد سعى إلى الاستيلاء على مطارها الدولي الوحيد كجزء من “مشروع فخ الديون” الخبيث – وهي رواية تم أيضاً فضحها مراراً وتكراراً من قبل كبار العلماء الأمريكيين. لقد وجدت، ومن خلال المحادثات مع المسؤولين الحكوميين الأوغنديين والتصريحات العامة لوزير المالية ماتيا كاسايجا، أن الصفقة لم تكن مفهومة بشكل جيد من قبل الدولة، ولكن لم يكن هناك أي شك في الاستيلاء على مطار عنتيبي الدولي، ورغم حقيقة أن قصة بلومبيرغ بمجملها حول هذا القرض بُنيت على كذبة، لم تُتهم بلومبيرغ بإثارة الفتنة والعمالة لواشنطن، وهذه هي قوة حرب المعلومات.
ثانياً، هناك ادعاء بشأن صلاتي المزعومة بالحزب الشيوعي الصيني استناداً إلى حقيقة بسيطة أنني أتناقش مع مثقفين صينيين ولدي وظيفة غير مدفوعة الأجر في معهد تشونغ يانغ للدراسات المالية في جامعة رينمين، وهي مؤسسة فكرية بارزة مقرها في بكين. ومع ذلك، فإن العديد من المنشورات الجنوب إفريقية التي قدمت هذه الادعاءات المشينة يتم تمويلها بشكل أساسي من قبل مؤسسة المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس. وجورج سوروس أخذ اسم مؤسسته من كتاب كارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعداؤه (1945)، الذي طور فيه مبدأ “التسامح اللامحدود”.
جادل بوبر من أجل الحد الأقصى من الحوار، وبأن الآراء المناهضة لآراء المرء يجب أن تُقاوَم “بالحجج المنطقية”. أين الحجج المنطقية هنا، في حملة التشهير التي تقول إن الحوار مع المثقفين الصينيين محظور بطريقة ما، لكن الحديث مع مسؤولي الحكومة الأمريكية مقبول تماماً؟ ما هو مستوى الفصل العنصري الحضاري الذي يتم إنتاجه هنا، حيث يروج الليبراليون في جنوب إفريقيا “لصدام الحضارات” بدلاً من “الحوار بين الحضارات”؟.
يمكن لبلدان الجنوب العالمي أن تتعلم الكثير من تجارب الصين مع الاشتراكية، ويمكن أن يعلمنا قضاؤها على الفقر المدقع أثناء الوباء – وهو إنجاز احتفلت به الأمم المتحدة – كيفية معالجة الواقع العنيف المماثل في بلداننا (وهو السبب الذي جعل معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي ينتج دراسة مفصلة حول الآليات التي وظّفتها الصين من أجل تحقيق هذا العمل الفذ). لا يوجد بلد مثالي في العالم، ولا يوجد بلد يسمو فوق النقد، لكن تطوير موقف مهووس تجاه بلد ما ومحاولة عزله أمر خطير اجتماعياً. إن الجدران بحاجة إلى هدمها وليس للبناء. إن الولايات المتحدة تثير صراعاً بسبب مخاوفها الخاصة بشأن التقدم الاقتصادي للصين: ولا ينبغي لنا الانجرار كأغبياء، بل نحن بحاجة إلى إجراء نقاش كالبالغين حول الصين، وليس نقاشا مفروضا علينا من قبل مصالح قوى لا تمثلنا.

لا تتناول مقالتي في صحيفة صنداي تايمز جميع القضايا التي تدور حول الصراع بين الولايات المتحدة والصين، ومع ذلك فهي دعوة للحوار، فإذا كان لديكم أي أفكار حول هذه القضايا يرجى مراسلتي عبر البريد الإلكتروني.