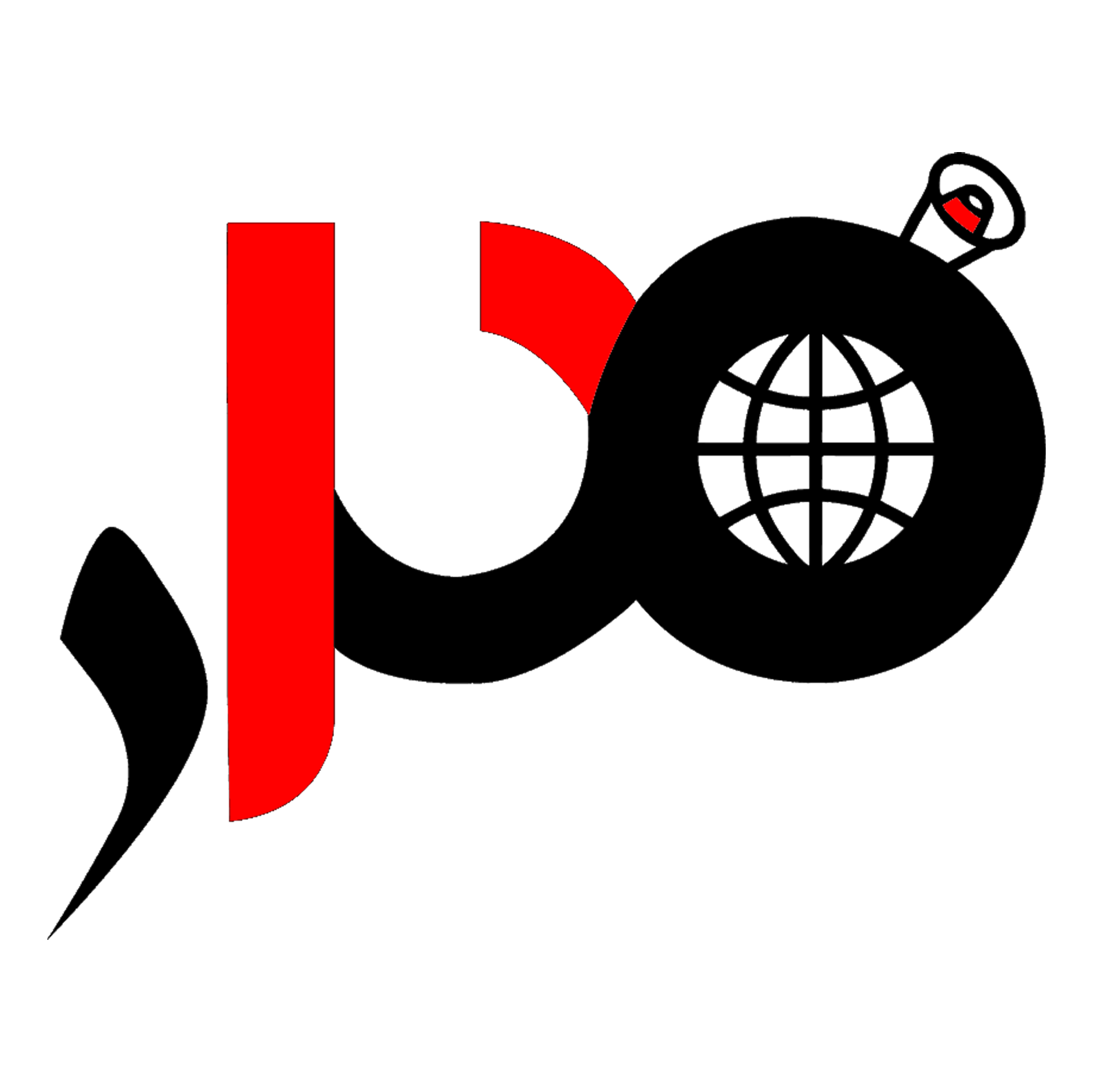مدار: 01 نيسان/ أبريل 2024
“واحد اتنين.. قرارات الريس فين”، بهتافهم الشهير صدح عمال شركة مصر للغزل والنسيج “غزل المحلة” في محافظة الغربية بدلتا مصر، في إضرابهم الأخير في شباط/ فبراير الماضي، مطلقين ما أشبه بصرخة تمرد ضد سياسات النظام من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعاملة جميع العمال والموظفين بالمثل دون تفريق، وبينما كانوا يمنون أنفسهم بالاستجابة لمطالبهم مراعاة لسوء أوضاعهم المهنية والاقتصادية، انتهى مصيرهم بفض الإضراب، وتوجيه إنذارات بفصل عدد منهم، واعتقال وإخفاء قسري لعدد آخر، وسط غضب كبير وقلق أكبر على واقع الطبقة العاملة في مصر في ظل هذه الممارسات.
أعاد الصخب الذي شهده إضراب المحلة الطبقة العاملة في مصر إلى المشهد مجددا، لينعش ذاكرة سلطة رأس المال بشواهد النضالات الاجتماعية التي زاد عمرها عن أكثر من قرن، ودورها في إعادة تشكيل التاريخ والحاضر والمستقبل، في مواجهة سياسات الاستغلال والاضطهاد، لذا كانت موجة القمع والتنكيل أكثر شدة وعنفا، ورسالة النظام أكثر وضوحا وحدة، تخوفا من الوعي العمالي المتزايد الذي كان عمال “المحلة” في مقدمته على مدار تاريخ الطبقة العاملة المصرية.
ضمن احتجاجات عارمة ضد سوء الأوضاع المعيشية خلال الأشهر الماضية، بدأ عدد من عاملات وعمال “غزل المحلة” إضرابا مفتوحا عن العمل في الثاني والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، احتجاجا عن استثنائهم من القرار الرئاسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 6 آلاف جنيه مصري (120 دولارا)، بدعوى تبعية الشركة لقطاع الأعمال العام الذي لا تشمله موازنة الدولة، رغم ملكية الدولة للشركة.
قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استثنى قطاع الأعمال العام، الذي تعد شركاته مملوكة للدولة بنسبة لا تقل عن 51%، وهو القطاع الذي تعرض لموجات من التصفية وإغلاق منشآته على مدار السنوات الأخيرة، فلم يعد يبق منه سوى بضع شركات ومصانع قليلة أبرزها “غزل المحلة” نفسها، كما لا يستفيد منه العاملون في القطاعات الأخرى وأعدادهم نحو 5 أضعاف موظفي الدولة.
يستوعب القطاع الخاص 80% من المشتغلين في مصر، مقابل 20% يعملون لدى الحكومة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2023 بلغت قوة العمل في مصر 31.101 مليون فرد. ويٌقدر عدد العاملين بالقطاع الخاص بنحو 21 مليون عامل، بينما يبلغ عددهم في القطاع غير الرسمي (الموازي) نحو 7 ملايين عامل.
إضراب “غزل المحلة” الذي بدأ بعاملات مصنع الملابس قبل أن يشمل عمال جميع مصانع الشركة، تزامن مع زيارة محافظ “الغربية” لأحد مصانع الشركة، لافتتاح معرض سلع غذائية مخفضة الأسعار، في وقت تمتنع الإدارة عن تعديل أجور العمال، أغلق الموظفون في قطاع الأمن أبواب مباني الشركة على العمال المضربين ومنعوا خروجهم، ما دفع المحافظ أيضا إلى إلغاء زيارته، وخوفا من تجمهر العمال قررت الإدارة إنهاء العمل قبل ساعة من موعده المعتاد.
لم تجد الإدارة أمامها سوى الدخول في خط التفاوض مع العمال، والاستجابة لمطالبهم جزئيا، وخوفا من اتساع رقعة الإضراب لتشمل شركات أخرى أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارا بمساواة عمال شركات قطاع الأعمال العام بالعاملين في الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية وعدم استثنائهم من زيادة الحد الأدنى للأجور عليهم، ما دفع عمال المحلة إلى إنهاء إضرابهم في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي.
رسالة تخويف لـ”عاصمة الطبقة العاملة”
تزامنا مع انعقاد الدورة الثانية من جلسات الحوار الوطني – الذي دعا إليه الرئيس المصري للحوار مع المعارضة، وبينما كانت الآمال كبيرة لمرحلة ما بعد إنهاء الإضراب، وجد العمال أنفسهم بين معرّض للفصل وسجين ومختف قسريا، ففي اليوم التالي تلقى عدد منهم استدعاءات أمنية، من بينهم عاملات، قبل أن يختفوا قسرا بعد توجههم إلى أحد مقرات الأمن الوطني، ويظهر عدد منهم لاحقا معتقلين – تم تجديد حبس عدد منهم منذ أيام عن طريق الفيديو كونفرانس دون حضورهم – بتهم بينها “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، بينما أصدرت الإدارة قرارات بفصل عدد آخر منهم.
أثارت هذه الممارسات سخطا واسعا في أوساط الشارع المصري والعمالي، واعتبرتها قوى سياسية وعمالية وجماعات حقوقية مصرية وعربية – في عريضة للتوقيع – “رسالة تخويف” من النظام ضد الطبقة العاملة، التي تركها بالفعل فريسة تحت أنياب رأس المال، مؤكدة أن “العمال استخدموا حقهم الدستوري والقانوني الأصيل في الإضراب عن العمل، ولم يخالفوا القانون في شيء يستوجب الحبس”، وأن “إضرابهم البطولي كان مثالا للتنظيم والسلمية والحفاظ على آلات وماكينات الشركة، بينما كان محرضهم الرئيسي هو سياسات الحكومة نفسها التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم، وموجات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة بعد التعويم المتكرر للجنيه، لذلك لم يكن الإضراب بسبب دعوة جماعات سياسية وتحريض من قيادات عمالية، بل كان هبة عفوية خرجت من بين عاملات غزل المحلة”.
عام 1927، أسست “مصر للغزل والنسيج” تحت إدارة طلعت حرب – أحد أهم أعلام الاقتصاد في تاريخ مصر – برأس مال بلغ حينها 300 ألف جنيه، وما يقارب 200 عامل فقط، وتم اختيار المحلة موقعا لها، وهي مدينة صناعية وزراعية كبيرة في مصر تقع في محافظة الغربية وسط دلتا النيل، قائمة بشكل رئيسي على أكتاف الطبقة العاملة، وساهمت في تحويل مصر من دولة تعتمد على استيراد النسيج إلى دولة تصدّره، كما تحمل تاريخا مشهودا من النضال الطبقي والتحرر، استحقت بفضله لقب “عاصمة الطبقة العاملة”، وكانت مركزا لصناعة النسيج والملابس في مصر القديمة وما بعده، كما كانت من أبرز مراكز النفوذ والحكم على فترات من تاريخ مصر.
“هنا في المحلة الكبرى قبل الثورة، وبعد الثورة، جرت مواقع هامة في النضال البطولي الذي خاضه الشعب المصري من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومن أجل العدالة الاجتماعية”… إدراكا للأهمية الإستراتيجية لـ”المحلة” لم يفوت رؤساء مصر فرصة للحديث عنها، فكان ذلك جزءا من خطاب للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر من داخل المدينة مطلع أيار/ مايو 1966.
أما خلفه محمد أنور السادات فكتب في اليوم ذاته من عام 1973، واصفا المحلة الكبرى بأنها “تجسيد كامل نضال الإنسان المصري في القرية وفي المصنع، أي نضال الفلاحين والعمال، أي نضال القوى القائدة في تحالف قوى الشعب العامل”.
وتضاعف رأس مال الشركة تدريجيا من 4 ملايين جنيه بحلول 1958 إلى ما يقارب 2 مليار جنيه في الوقت الحالي، ووصل حكم العمالة بها إلى 35 ألف عامل عام 1986، قبل أن يتضاءل العدد تدريجيا ليصل إلى ما يقارب 14 ألفا فقط حاليا، مع استفحال سياسات الفصل ووقف التعيينات والإحالة للمعاش المبكر، ضمن سياسات تصفية القطاع العام وضرب القلاع الصناعية الرئيسية.
قبل بدء إضراب المحلة الأخير اتخذت الحكومة وإدارة الشركة قرارات وصفها كثير من العمال بأنها محاولة لتصفيتها تمهيدا لخصخصتها – بيعها للقطاع الخاص – أو إغلاقها، بدأت بوقف التعيينات منذ سنوات، وتقليص حجم العمالة بخروج حالات المعاش أو الإصابة، والسيطرة على تنظيمهم النقابي.
وتتعامل الدولة المصرية مع الاحتجاجات العمالية (أصحاب الشركات في القطاع الخاص – الإدارات في الشركات المملوكة للدولة – الأجهزة الأمنية – القضاء – القانون) على أكثر من مستوى من الضغط، تشمل الامتناع عن دفع الأجر، والمنع من التظاهر والإضراب والاعتصام، التهديد بالفصل، وتحييد القيادات العمالية، وصولا إلى الاستدعاءات الأمنية والاعتقالات، في وقت تقف التعديلات الجديدة في قانون العمل عاملا مساعدا في تشريدهم، إذ تعطي لصاحب العمل حق إنهاء العقد من طرف واحد، وتضع اشتراطات للاحتجاج تصل إلى حد تجريمه، بحسب المحامي الحقوقي مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمختص في التقاضي العمالي.
في هذا السياق، اعتمدت السلطة مخططا متعدد الأوجه لمحاولة إخضاع الطبقة العاملة ومحاصرتها من جميع المنافذ؛ واقتصاديا ونقابيا وأمنيا واجتماعيا.
سجناء “لقمة العيش”
بالإضافة إلى عمال “المحلة” المعتقلين، يقبع العديد من العمال في سجون النظام بسبب نشاطهم في الدفاع عن حقوقهم وحقوق زملائهم، فقط يكفي صاحب العمل استدعاء الأمن لهم بدعوى “تعطيل ماكينة الإنتاج” للزج بهم في السجون لأشهر وربما سنوات، بتهم معلبة موحدة: “الانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بالأمن العام”.
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، دخل عمال الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو” في إضراب عن العمل للمطالبة بمستحقاتهم المالية واحتجاجا على الإجراءات التعسفية للإدارة ضدهم، فألقت الشرطة القبض على عدد منهم، حينها نظم الناشط العمالي خليل رزق حملة للمطالبة بالإفراج عنهم وتلبية مطالبهم، ليتم بعد أيام القبض عليه هو الآخر باتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب جريمة.
18 شهرا كاملة قضاها رزق دون أن يعلم تهمته، قبل صدور قرار في 2021 باستبدال حبسه احتياطيا بأحد التدابير الاحترازية، إلا أنه رغم ذلك يواجه تخوفات يومية من احتمال إعادة القبض عليه نظرا لاستمراره في نشاطه النقابي بعد إخلاء سبيله، بحسب ما يحكي لـ”مدار”.
السلطات باتت تستخدم الاعتقالات كسلاح لتحويل مسارات احتجاجات العمال، وتغيير دفتها من المطالبة بحقوقهم إلى قصرها على دعوات الإفراج عن زملائهم، والضغط على أسر المحبوسين أنفسهم لدفع زملاء ذويهم لإنهاء احتجاجاتهم بدعوى تسببها في حبسهم، وهو ما ينهي هذه الاحتجاجات في مهدها في كثير من الأحيان، بحسب رزق.
أما في ما يخص الشركات ذات السمعة والتأثير الشهيرين كـ”غزل المحلة” فيتم استبدال القبض بما يسمى “الاستدعاء الأمني“، إذ تطلب سلطات الأمن الوطني أسماء عشوائية من المشاركين في الاحتجاجات العمالية للحضور إلى مقراتها للاستجواب، ليتم بعدها التنكيل بهم وتهديدهم باعتقالهم أو أفراد أسرهم، وعلى الجانب الآخر محاولة تفريقهم عن زملائهم وإضعاف إضراباتهم.
بعد 2013، بدأ التعامل مع هذه الاحتجاجات كملف أمني حصريا، بعد تخلي وزارة القوى العاملة واتحاد النقابات الحكومي عن دورهما في حماية حقوق العامل والدفاع عنه، حتى بات الفصل التعسفي أقل مخاوف الطبقة العاملة وطأة، بعد أن وصل الأمر ببعضهم إلى حد التعرض للقتل.
في منتصف 2015، لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرون وجميعهم من العاملين في شركة أسمنت بسيناء، بعد إصابتهم بأعيرة نارية، وفي وقت صرحت السلطات بأن استهدافهم كان من مجهولين، أشارت تقارير أخرى إلى أن استهدافهم جاء من قوة أمنية بعد تجمهرهم للمطالبة بفتح الطريق أمام سيارة إسعاف لإنقاذ أحد زملائهم الذي تعرض لإصابة عمل أدت إلى وفاته لاحقا.
انتخابات نقابية كرتونية.. صوت العمال تحت قبضة السلطة
أحد المؤثرات الأخرى في واقع الحركة العمالية المصري حاليا هو غياب ديمقراطية التنظيمات النقابية وفقا لمدير المركز المصري، الذي أشار إلى تدخلات الدولة بشكل قاس للتحكم في التنظيمات النقابية واختيار قياداتها، فضلا عن إلغائها حرية تكوين النقابات المستقلة وفقا لتعديلات قانون العمل، فبات أعضاء مجالس إدارات النقابات المختلفة واللجان النقابية المختلفة لا يمثلون العمال بل صاحب العمل، في وقت تتحكم السلطة بشكل كامل في اختيار أعضاء اتحاد العمال الحكومي، أو ما يسمى “الاتحاد الأصفر”.
وتزامنا مع “الحوار الوطني” بين السلطة والمعارضة شهدت انتخابات النقابات العمالية الأخيرة في مصر لدورة “2022- 2024” عملية تصفية من المنبع كفاعلية ديمقراطية تهدف إلى تمثيل العمال، إذ تم حرمان عدد كبير من المرشحين في الانتخابات من حقهم في الترشح، سواء بتدخل مباشر من الأجهزة الأمنية، لتهديدهم وترويعهم قبل تقديم الأوراق وفقاً لروايات الشهود، أو استبعادهم عقب تقدمهم دون إبداء أي أسباب ورفض طعونهم، بحسب قوى سياسية وعمالية مصرية.
تركت نتائج الانتخابات الأخيرة عموم عمال وعاملات مصر دون ممثلين وممثلات حقيقيين قادرين على التفاوض بأسماء زملائهم، وإنقاذ عموم العمال من دوامة لا تنتهي من الإفقار في سياق توزيع أكثر عدالة لأعباء الأزمة التي تدفع ثمنها بالأساس الفئات الأضعف من العمال والموظفين والفلاحين، الذين تزداد ظروف معيشتهم سوءًا، ويفقدون قدراتهم على الحفاظ على حياة كريمة لأسرهم في سياق موجات إفقار لا تتوقف.
يرى عدلي أن “الحركة النقابية باتت تعيش أسوأ مراحلها حاليا، فالقوانين المنظمة لانتخابات النقابات العمالية معيبة بشكل فج، حتى أصبح التظلم والطعن في النتائج من الممارسات غير القانونية”، لافتا إلى أنه رغم التقدم بطعون في نتائج الانتخابات الأخيرة لم تبت المحكمة العمالية فيها رغم مرور أكثر من عامين على إقامتها.
الحصول على تصريح قانوني بتنظيم إضراب في مصر أشبه بمهمة مستحيلة، ولا يدفع في اتجاهه إلا الممثلون الحقيقيون للعمال في انتخابات تمثلهم، أما بعد السيطرة شبه الكاملة عليها في الوقت الحالي، ولتوضيح حجم خطورة السيطرة على الكيانات النقابية في مصر، تكفي الإشارة إلى أن عددا من أعضاء مجالس النقابات المنتخبين بدعم من الدولة هم أنفسهم من يرسلون قوائم بأسماء العمال المتقدمين بطلبات لفعاليات احتجاجية، تمهيدا لاستهدافهم بالفصل أو التهديد أو السجن، وهو الأمر الذي حدث بالفعل من ممثلي النقابة العامة للغزل والنسيج في الإضراب الأخير لعمال المحلة، بحسب الناشط النقابي خليل رزق.
ويؤكد رزق أن “التحكم في صوت العمال” والقبضة الأمنية كانت لهما تأثيرات بالغة لاحقا على واقع الطبقة العاملة في مصر، فأطلقا أيدي أصحاب العمل لمزيد من الممارسات التعسفية بسيل من قرارات الفصل والانتقاص من الأجور والامتناع عن دفع المستحقات وغيرها. كما أن تدخلات “الأمن الوطني” في المسارات التفاوضية يدفع العمال في كثير من الأحيان إلى القبول بشروط غير مرضية لهم، وبينما يتم إجبارهم على العودة للعمل دون حل جذري لمشاكلهم سرعان ما يعودون للإضراب بشكل أكبر تتوسع فيه دائرة المطالب مع توسع دائرة الأزمات.
القضاء العمالي.. تقنين للفصل و”تعويم” يلتهم التعويضات
يشير مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن القانون المصري بالتعديلات الحالية لا يعالج تأثيرات الفصل التعسفي بشكل جدي، نظرا لعدم تفعيل عدد كبير من نصوصه، ومنها إلزام المحكمة العمالية بحكم مستعجل واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرًا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، وأن تفصل – على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه – في طلب صاحب العمل فصل العامل خلال 15 يومًا من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل في عمله و بإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا لنص المادة (122) من هذا القانون.
المحاكم العمالية تتعنت أيضا في إعادة العمال إلى وظائفهم ما لم يكونوا نقابيين، اعتمادا على ثغرات قانون العمل، وتكتفي – بعد أشهر أو سنوات – بتعويض العامل فقط عن فصله تعسفيا. ومع بدء تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، تراجعت قيمة العملة الوطنية لتفقد أضعاف قيمتها، فيما تشهد البلاد بالتوازي مع ذلك موجة من ارتفاع الأسعار، ما يقتضي – بحسب عدلي – وجود تدخلات تشريعية عدة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، تعزز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، أو الفئات المعرضة للمصير ذاته، وعلى رأسها العمال المفصولون.
وتحت تأثير تطبيق سياسة سعر الصرف المرن فإن العملة فقدت جزءا كبيرا من قيمتها، ما يؤثر بدوره على القوة الشرائية لهذا المبلغ وعلى قيمته الفعلية، وهي إشكالية كبيرة تهدد القيمة الفعلية المستحقة للعمال وتشكل خطرا بالغا على أوضاعهم الاقتصادية المأساوية بالفعل.
“المركز المصري” طرح مبادرة من أجل تجنب آثار السياسات النقدية على القيمة الحقيقية للمبالغ المحكوم بها في القضايا العمالية، مراعاة للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وتتأثر بها جميع فئات المجتمع، مؤكدا أنه إذا كان التعويض المقضي به للعامل في ظل سعر صرف يساوي فيه الدولار 15 جنيها مصريا فإن تنفيذ هذا الحكم بالمبلغ ذاته عقب انتهاء مراحل التقاضي وإتمام الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الآن يعني فقدان هذا المبلغ 50% من قيمته أو قوته الشرائية – حينما كان الدولار يعادل 32 جنيها في البنوك قبل وصوله إلى ما يقارب 50 جنيها بعد القرار الأخير بتحرير سعر الصرف بشكل كامل – وبالتالي فإن هذا الوضع يشكل انتقاصا من حقوق العامل في التعويض، وتحويل مسألة التعويض لمسألة شكلية، في ظل ضعف مبالغ التعويض في الغالب الأعم من القضايا العمالية الناتج عن تدني هياكل الأجور في قطاعات واسعة من القطاع الخاص.
وشهدت الساحة العمالية في مصر خلال العام الحالي بداية حراك عمالي لأسباب عدة، أهمها عدم تناسب الأجور مع الأسعار السائدة في المجتمع وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع العمال للمطالبة بمستحقاتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون في ظل رفض إدارات الشركات هذه المطالب.
استمرت الاحتجاجات العمالية للعام 2023، لكنها كانت أقل من العام الماضي بشكل ملحوظ رغم مبررات اشتعالها، فالضغط الاقتصادي على أرباب الأعمال، وارتفاع سعر الفائدة في البنوك، في مقابل تقلص هامش الربح، فضلًا عن نقص العملة، والمواد الخام، جميعها عوامل دفعت الكثير من أصحاب العمل إلى التهديد بسلاح تقليص العمالة، أو حتى التصفية، في مواجهة أي تذمر، أو احتجاج، وهو ما أثر قطعًا على عدد الاحتجاجات، وكذلك المماطلة وعدم الاستجابة لأغلب مطالبها، وعليه أصبح العمال بين سندان صعوبة العيش الكريم ومطرقة الفصل أو التصفية.
إحصائيات خادعة.. وعدوى النضالات الجماعية تنتشر
رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية نحو 10634 انتهاكاً تعرضت لها العاملات والعمال خلال عام 2022 في مصر، مقابل 6241 انتهاكا فقط في العام التالي 2023، وتركزت الأغلبية العظمى منها في القطاع الخاص، يليه قطاع الأعمال العام، ثم القطاع الحكومي.
قد تبدو الأرقام المذكورة مبشرة بالإشارة إلى قلة عدد الانتهاكات، إلا أن اقتصاصها من سياقها قد يبدو مضللا بعض الشيء، خاصة مع التطرق للأسباب الحقيقية وراء هذه الإحصائية، وعلى رأسها تدخلات ما تم ذكره بشأن تحالف السلطة مع رأس المال لمحاولة الفتك بالطبقة العاملة، بالفصل والامتناع عن دفع الأجور، وغيرها، فضلا عن الممارسات الأمنية، وغياب الإنصاف القضائي والقانوني للعمال، بالإضافة إلى التأثيرات المرعبة للسياسات الاقتصادية للسلطة، وهو ما يظهر في حالات الانتحار التي شهدها مصنع “يونيفرسال” لـ5 من عماله، بعدما ضاقوا ذرعا من تدخل الدولة لدفع الإدارة إلى صرف مستحقاتهم المتأخرة، رغم أن الامتناع عن دفع الأجور ووقف العمل بالمصانع لتسريح العمالة جرائم يعاقب عليها القانون.
بدا للجميع أن إضراب غزل المحلة كان معديا بشكل واضح، فبعد 4 أيام من بدئه سار عمال شركة الزيوت والمنظفات بمحافظة أسيوط في صعيد مصر على خطاهم بإعلانهم الإضراب عن العمل للمطالبة بعدم استثنائهم من قرار الحد الأدنى للأجور المقدر بـ6 آلاف جنيه شهريا للعاملين بقطاع الأعمال العام، أسوة بالعاملين في الحكومة.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، ففي اليوم الذي قرر عمال “المحلة” إنهاء إضرابهم، أعلن عمال شركة الإسكندرية للإنشاءات التابعة لـ”مجموعة طلعت مصطفى”، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى – المدان بقتل المطربة سوزان تميم قبل خروجه بعفو رئاسي في 2017 – الاعتصام احتجاجًا على تدني أجورهم، كما أعلن عمال الشركة التركية للملابس “تي آند سي جارمنت” بمحافظة القليوبية إضرابهم عن العمل للمطالبة بتعديل أجورهم.
إضراب “المحلة” سبقته أيضا احتجاجات عمالية واسعة، شملت شركات “يونيفرسال”، و”نايل لينين”، و”كير سيرفيس” في معسكرات قوات حفظ السلام في سيناء، و”الحديد والصل” و”فحم الكوك”، و”كريازي” وغيرها، بمطالب شبه موحدة على رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور وتعيين العمالة المؤقتة ووقف قرارات الفصل التعسفي، والحق في نسبة من الأرباح، ورغم ما واجهه العمال من قمع وممارسات تعسفية على خلفية احتجاجاتهم إلا أن خروجهم ساهم في تحفيز ثقافة النضال الجماعي ضد سلطة رأس المال.
ولم يغب مشهد إضراب عمال غزل المحلة الشهير في ديسمبر 2006 – الذي شكل نقلة محورية في حركة الطبقة العاملة في مصر بتكريس مفهوم الاحتجاج السلمي كأحد وسائل التفاوض من أجل حقوق العمال فضلا عن دوره في التمهيد لثورة 25 كانون الثاني/ يناير لاحقا – عن ذهن النظام الحالي، الذي لا يرى منفذا لتحركات الجماهير إلا وأغلقه، وواجهه بالقمع والترهيب، ربما تخوفا من هبة شعبية جديدة قد تطيح به على غرار سلفه محمد حسني مبارك.
لا يمكن تفسير الممارسات ضد عمال “المحلة” وغيرهم بأنها مجرد انتهاكات عفوية كرد فعل على احتجاجاتهم، وإن لم يكن من الممكن استبعادها كأحد الأسباب، بل إنها قد تمتد لتكون إشارة واضح إلى استهداف متكرر لأي محاولة تحرك منظم داخل صفوف الطبقة العاملة، خاصة مع تاريخها النضالي الممتد والمؤثر في طريق الكفاح الجماعي لمزيد من المكتسبات لصالح أغلبية الشعب، بينما كانت دوما شرارة اشتعال العديد من الانتفاضات التي مهدت للإطاحة بأنظمة، آخرها نظام مبارك بعد إضراب 2006 الشهير، وهو ما قد يمثل تخوفا دائما للنظام الحالي من أن يلقى مصيرا مماثلا، ويفسر كثيرا من ممارساته.