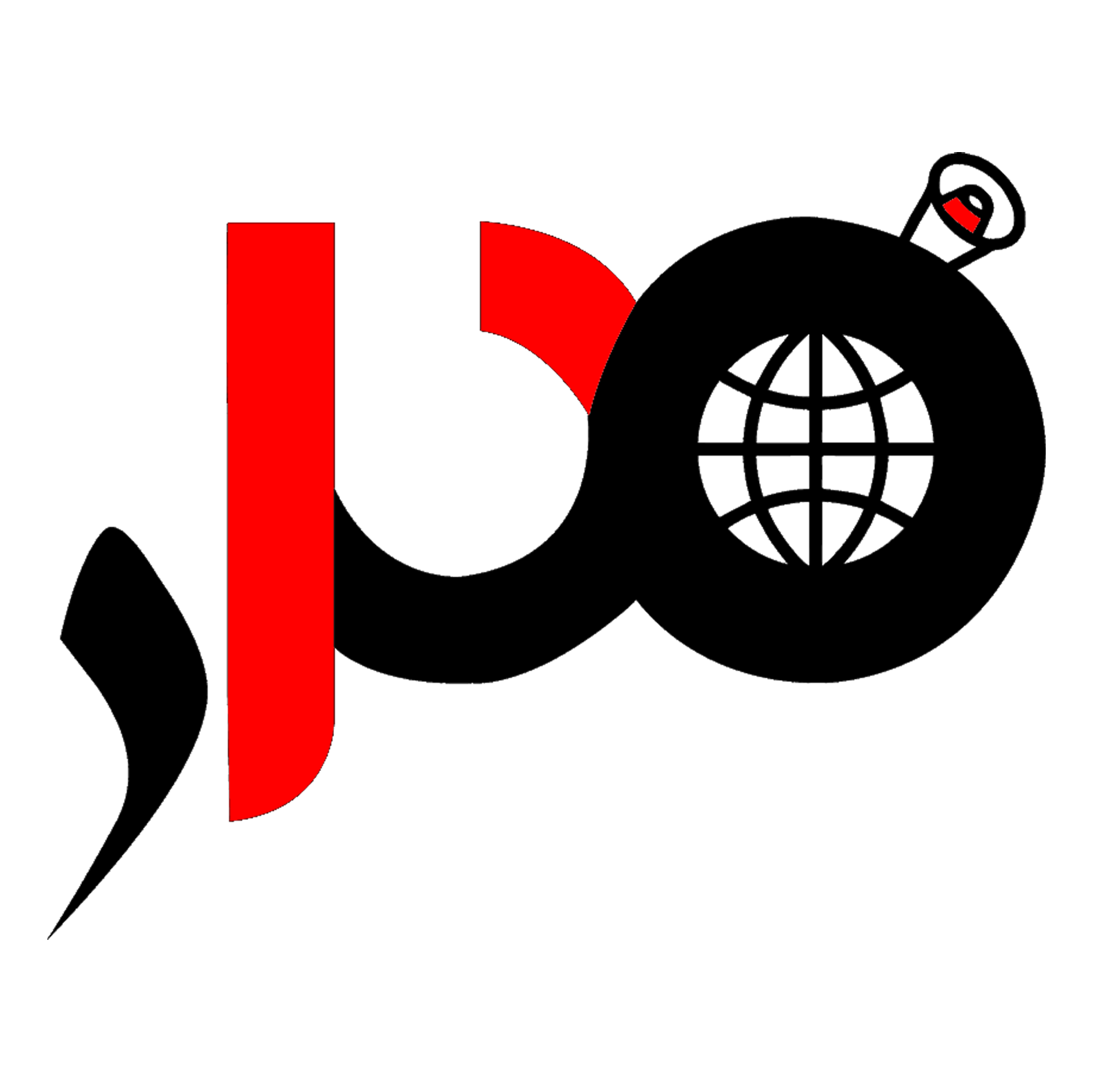صوة: DR
نيو فريم / مدار: 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
نيل أوفري
لن يتوقف الهجوم المستمر والمتزايد للرأسمالية على المحميات البيئية إلا إذا قمنا بتغيير جذري في طريقة تصورنا لقيمتها والغرض من وراء وجودها.
تعرف منطقة مبومالانجا في جنوب إفريقيا حاليا صراعا محتدما حول الأحقية في استخراج الفحم المتواجد في المحمية البيئة مابولا (MPE). هذه المحمية التي تم الإعلان عنها من قبل إدارة مقاطعة مبومالانجا عام 2014، والتي تضم 70000 هكتار من الأراضي العشبية والأراضي الرطبة، تعتبر روافدها المائية رئيسية في نظام نهر أوسوتو، كما أنها تصنف ضمن المناطق شديدة الأهمية لإمدادات المياه، إلى درجة أنها تستحضر باعتبارها مصدرا إستراتيجيا للمياه من قبل المعهد الوطني للتنوع البيولوجي في جنوب إفريقيا ومجلس البحث العلمي والصناعي.
ورغم الأهمية التي يجب أن تولى للمحمية، نظرا لما تمثله ضمن المنظومة البيئية، إلا أنه بعد أقل من عامين من إعلانها منطقة محمية منح وزير المياه والشؤون البيئية آنذاك، الراحل إدنا موليوا، وأكد ذلك وزير الموارد المعدنية موسيبينزي زواني، شركة التعدين الهندية -Atha-Africa Ventures- ترخيصا لتعدين 2.25 مليون طن من الفحم سنويًا في MPE. ويعتبر العقد ساريا لـ15 عاما من تاريخ توقيعه.
بعد توقيع العقد الذي اعتبر غريبا، تم الطعن فيه على الفور من قبل عدة مجموعات بيئية بقيادة مركز الحقوق البيئية في المحكمة العليا في بريتوريا، مستغلة في ذلك تنصيص إدارة البيئة الوطنية في قانون المناطق المحمية لعام 2003 على أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار إلا في “ظروف استثنائية”، وفقط بعد تطبيق “المبدأ التحذيري”.
في عام 2018، وجدت المحكمة العليا أن الوزراء لم يطبقوا “مبادئ تحذيرية” في اتخاذ قرارهم، وبالتالي حكمت بإلغائه. وبدافع من شركة Atha-African Ventures، استأنفت الحكومة أمام محكمة الاستئناف العليا في أوائل عام 2019، وخسرت مرة أخرى، قبل أن تخسر استئنافها أيضا أمام المحكمة الدستورية في نونبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
والظاهر أن هذه الهزائم والانتكاسات لم تردع أصحاب القرار، إذ هدد فوسي شونغوي، عضو مبومالانجا في المجلس التنفيذي للزراعة والبيئة، بتغيير حدود MPE لاستيعاب المنجم؛ وقد صرح بأنه سيقتطع حوالي 10٪ من منطقة البحر المتوسط باستخدام المادة 24 من قانون المناطق المحمية، التي تخول للسلطة التي أنشأت منطقة محمية القدرة على تعديل حدودها.
من المستفيد؟
إذا تمعنا في كم الحماس الذي يتم من خلاله متابعة هذا التعدين، يمكن التوصل إلى أن المستفيدين من تمكين السود في المنجم هما Sizwe Zuma وVincent Zuma، أبناء أخ رئيس الدولة السابق جاكوب زوما، بالإضافة إلى أنه بالنظر إلى العلاقة الحميمة التي تربط بين عناصر من عائلة زوما وعائلة الوزير السابق زواني، الذي كان أحد مهندسي رؤية التعدين، فإن هنالك توافقا على رؤية هذا المشروع يمضي قدما.
الأوضاع التي تعيشها مبومالانجا هي نموذج لآلاف الحالات المماثلة التي تحدث في جميع أنحاء العالم، حيث تكون المناطق المحمية سابقا، إما مستغلة بالفعل أو مهددة بالاستغلال من قبل الصناعات الاستخراجية.
تعرف مثل هذه الأحداث عموما بخفض مستوى المناطق المحمية وتقليص الحجم والتحلل. لقد أصبح الوضع سيئا للغاية إلى درجة أنه تم إنشاء موقع ويب لتتبع ورسم خريطة كل انتهاك، أو انتهاك محتمل، في المناطق المحمية. في السنوات الأخيرة، وخاصة في الأشهر القليلة التي تلت إغلاق معظم البلدان نتيجة كوفيد-19، تتسارع عدد الأحداث المتعاقبة، لاسيما مع قيام قادة مثل دونالد ترامب (الولايات المتحدة) وجاير بولسونارو (البرازيل) وناريندا مودي (الهند) بفتح مناطق محمية سابقًا للصناعات الاستخراجية، مثل التعدين وتربية المواشي والنفط والغاز..
وتتعرض أجزاء كبيرة من إفريقيا لتهديد مماثل، فمنتزه فيرونجا الوطني الموجود في جمهورية الكونغو الديمقراطية مهدد بالتنقيب عن النفط، كما أن منطقة شلالات مورشيسون المحمية في أوغندا تم تأكيد حفر 400 بئر نفط بها، بالإضافة إلى تعدين اليورانيوم الذي يحلق فوق محمية سيلوس غيم في تنزانيا؛ في حين تمت مناقشة تعدين النحاس في حديقة زامبيزي السفلى الوطنية في زامبيا.
وترجع القوة الدافعة وراء هذا الهجوم غير المسبوق على المناطق المحمية في العالم إلى المحرك الاقتصادي؛ فالعالم يقترب من ذروة إنتاج العديد من المعادن الضرورية لاستمرار إعادة إنتاج علاقات الإنتاج والاستهلاك الرأسمالي.
“النضوب الاقتصادي”
في حين أن مفهوم ذروة النفط وجد له موطئا وتم التعامل معه مبكرا، خصوصا أنه يعود إلى استنتاجات عالمة الجيولوجيا الشهيرة ماريون هوبرت عام 1956، فإن مفهوم ذروة المعادن اكتسب صيتا وأصبح عنصر جذب، خصوصا بعد نشر مجموعة روما للتنقيب عام 2014 كتيبا حول: نضوب المعادن العالمية بين الماضي والحاضر والمستقبل.
يكشف هذا التقرير أن العديد من المعادن، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النحاس والزنك والكادميوم واليورانيوم والتيتانيوم والقصدير والليثيوم والنيكل والبلاتين، تواجه ذروة إنتاجها في الوقت ما بين عام 2040 ونهاية القرن.
تماما مثل الزيت، لا يواجه أي من هذه المعادن نضوبًا فعليا. بدلا من ذلك، أصبح من الصعب بشكل متزايد إنتاجها اقتصاديا لأن رواسب الخام التي يسهل الوصول إليها أو عالية الجودة يتم استنفاذها بسرعة، ما يضع المنتجين أمام نضوب آخر يجب التعامل معه، وهو “النضوب الاقتصادي”.
في النفط، تجلى هذا في استغلال ما تسمى المصادر غير التقليدية، مثل النفط الصخري الذي يتم استخراجه فقط عندما يكون سعر النفط مرتفعا بما فيه الكفاية، وذلك من خلال عمليات محفوفة بالمخاطر للغاية في المياه العميقة. ويمكن أن يؤدي التنقيب في المياه العميقة إلى حوادث مهولة مثل كارثة ديب ووتر هورايزون عام 2010 في خليج المكسيك، كما أنه من الجدير بالذكر أن هذه الكارثة وأسوأ قابلة للحدوث، لاسيما بعد قرار شركة “توتال” التنقيب عن الغاز قبالة الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا، ما يجعل المياه في خطر أكبر بكثير من مياه خليج المكسيك.
وفي ما يتعلق بالمعادن، تؤدي الذروة إلى الضغط لاستغلال المصادر المتاحة بسهولة أكبر، والتي يقع العديد منها حتما في مناطق محمية غير مستغلة سابقا.
في حين أن إعادة التدوير واستبدال المواد الأولية – استبدال المعادن التي تفتقر إلى المعروض ببدائل متاحة بسهولة أكبر – والابتكارات التكنولوجية، يمكن أن تخفف الضغط على الموارد المتبقية، بالنظر إلى أنه لا يمكن المناجم الحالية أن تلبي ولو نسبة صغيرة من الطلب الحالي المتزايد على هذه المعادن. إذا لم نرغب في تحويل المناطق المحمية إلى مناطق تضحية، فإن التغيير الأساسي ضروري.
المنظور الاستعماري
كنقطة انطلاق، نحتاج إلى إعادة النظر في معنى المناطق المحمية، وبالتالي الغرض منها. تاريخيا، تم إنشاء هذه المحميات الطبيعية أو كما يسميها عالم الاجتماع جاكلين كوك “منظور الحفظ الاستبدادي”، الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية. وقد أعطى هذا المنظور الأولوية لالتقاط الموارد أو المناظر الطبيعية للأنظمة الاستعمارية (مثل الأخشاب في الهند أو صيد النخبة في إفريقيا) والحفاظ على الحيوانات الضخمة الشهيرة.
وتضمنت هذه العمليات الإبعاد القسري للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق. وتظهر لنا الأدلة الحالية على أن الناس الذين عاشوا بشكل عام في المناطق التي تم تحويلها إلى محميات كانوا في وئام مع بيئاتهم في تناقض حاد مع الافتراضات الاستعمارية بأنهم كانوا يضرون بها.
كما أن الرغبة في الحفاظ على حيوانات ومناظر طبيعية معينة تم تحديدها من خلال ما أطلق عليه المؤرخ ويليام كرونين “أسطورة الحياة البرية”. ويجادل كرونين بأن اللهفة إلى إنشاء مناطق محمية كان مدفوعا أيضا بالرغبة في الحفاظ على “المناظر الطبيعية البكر” الأسطورية “غير الملوثة” من قبل البشر. ولكن، كما هو معروف، لم يكن مثل هذا المشهد موجودا على الإطلاق، كما أنه لا يمكن تحقق ذلك إلا من خلال طرد السكان، ما يعني أن المناظر الطبيعية “البرية” هي مناظر طبيعية مبنية اجتماعيا بهذه الطريقة، بحيث لا يعتبر البشر جزءا من الطبيعة.
في حين بُذلت بعض الجهود في السنوات الأخيرة لإعادة دمج المشردين في المحميات الطبيعية والمتنزهات، إلا أن فكرة المناطق المحمية على أنها “مناظر طبيعية بكر” مازالت قائمة إلى حد كبير. تكمن المشكلة في هذا من حيث صلته باستخراج الموارد، خصوصا من حيث ما هو معرض للخطر من التعدين أو قطع الأشجار أو تربية المواشي؛ فبدلا من أن يكون نقاشا دقيقا حول كيفية تأثير الصناعات الاستخراجية على جميع الكائنات الحية (بما في ذلك البشر)، فإن الخلاف حول الاستخراج في المناطق المحمية يتحول إلى معركة مبسطة بين الفوائد المزعومة “للتنمية” والحفاظ على الحيوانات “الأصلية” أو المناظر الطبيعية.
هذا الوضع وطريقة التفكير تتيح لمن يدعمون التنقيب الادعاء بأن حياة الحيوانات تحظى بالأولوية على حياة الإنسان، وهذه هي الطريقة التي يتم من خلالها النقاش الحالي حول MPE في مبومالانجا.
في مايو، صرح Shongwe بأن “الناس في المنطقة حريصون على فتح المنجم بسبب الفرص الاقتصادية التي سيخلقها. لكن الغرباء، الذين لا يفهمون مدى الفقر هنا، يعارضونه … المعدة الفارغة لا تفهم الكثير من هذه الحجج البيئية”.
قيمة سلعة
نحتاج أكثر فأكثر إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في كيفية تصورنا للمناطق المحمية من حيث كيفية تقديرنا لها، لاسيما في ظل تحولها إلى سلعة تحت نير هجوم النيوليبرالية، في محاولة يائسة لإظهار أهمية المناطق المحمية في عالم يتم فيه تقسيم كل شيء ويكون له معنى فقط إذا كان من الممكن إعطاؤه سعرا في السوق، ما حذا بمجموعة من الحكومات والمنظمات البيئية إلى تبني حلول قائمة على السوق، مبررة ذلك بمحاولة الحفاظ عليها.
هذه الظاهرة، التي وصفتها الجغرافي كاثلين ماكافري بأنها “بيع الطبيعة لإنقاذها”، أدت إلى استغلال المناطق المحمية كمؤسسات تدر الأموال. لقد ساهم هذا الفهم في بسط وتوطين سلطة الحدائق الوطنية في جنوب إفريقيا. وتشير نظرة سريعة على أحدث الخطط الإستراتيجية الخاصة بهذه المحميات إلى تطوير “بنية الأعمال” الخاصة بها من أجل “زيادة عائدات السياحة، وتنويع المنتجات” و”تعزيز تجربة العملاء”. ولكن كما يبرز عالم الاجتماع برام بوشر فإنه من خلال الاشتراك في هذه الممارسات والأدوات المعيارية النيوليبرالية، يصبح النمو الاقتصادي بشكل غريب شرطا أساسيا لبيئة صحية.
وتم إصدار تقرير حديث عن معهد جنوب إفريقيا لحماية التراث الطبيعي لأفريقيا تحت عنوان: حالة التعدين في المناطق المحمية، ويشير إلى أن “تصنيف الحفظ، مثل تصنيف التراث العالمي، يمكن أن يترجم إلى توليد دخل كبير …”.. و”لزيادة نجاح المناطق المحمية كأدوات للحفاظ على الطبيعة، من المهم الاعتراف بالمكاسب الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تحققت من الحماية المعينة المناطق”.
إن كيفية ارتباط ذلك باستخراج الموارد في المناطق المحمية أمر بالغ الأهمية، كما أوضح مجموعة من الأكاديميين بقيادة الجغرافي كاترينا ماكنزي، الذين درسوا ديناميكيات التنقيب عن النفط في منطقة شلالات مورشيسون المحمية، وخلصوا إلى أنه من خلال تخصيص قيمة رأسمالية مالية للطبيعة تصبح المناطق المحمية في الواقع أكثر عرضة للاستغلال، وأشاروا إلى أن “هذا يحدث لأن الطبيعة سلعة، ما يسمح للقيمة الاقتصادية وربحية استخدامات الأراضي داخل منطقة محمية بتحديد أولويات كيفية استغلال الطبيعة”.
وهكذا، من خلال دعم المنفعة الاقتصادية وقيمة المناطق المحمية، فإنها تقع بسهولة أكبر في الأنماط المعيارية للاستخراج والاستهلاك ويتم إنشاء بوابات أكبر للصناعات الاستخراجية. ولعل اقتباس Audre Lorde الشهير بأن “أدوات السيد لن تفكك منزل السيد أبدا” مناسب لوصف أنه لا يمكن لشركات التنقيب أن تضر نفسها أبدا ولو كان على حساب الطبيعة.
استشراف الرؤى
ماذا يمكننا أن نفعل؟ كخطوة أولى يجب أن نتخلى عن الرؤى المثالية للطبيعة البكر التي لم يلوثها البشر. ومن خلال القيام بذلك، سنبدأ في قبول الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن البشر كانوا ومازالوا وسيبقون دائما جزءا من الطبيعة، مم سيسمح لنا بتصور صيغ بديلة حيث يتشابك البشر ويمتزجون “بالطبيعة”.
وبالتالي، عندما تتعرض منطقة محمية للتهديد من قبل الصناعات الاستخراجية، فلن يكون الأمر متعلقا بالطبيعة مقابل البشر بقدر ما يتعلق بالضرر الذي من المحتمل أن تحدثه هذه الصناعات لجميع أشكال الحياة المترابطة في سياق حالة الطوارئ المناخية الجارية.
ثم نحتاج أيضًا إلى فحص وتقييم أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تقود البحث اللامتناهي عن المعادن. نحتاج إلى استجواب القوى الاجتماعية والثقافية التي تستمر في تشكيل ما نعتقد أننا بحاجة إليه، أو كيف يجب أن نتصرف لنعتبر “ناجحين” في سياق رأسمالية القرن الحادي والعشرين المبكرة.
هذه دعوة عاجلة لأن آخر جبهة كبيرة للصناعات الاستخراجية، والمتمثلة في المحيطات، أصبحت الآن في مرمى البصر.