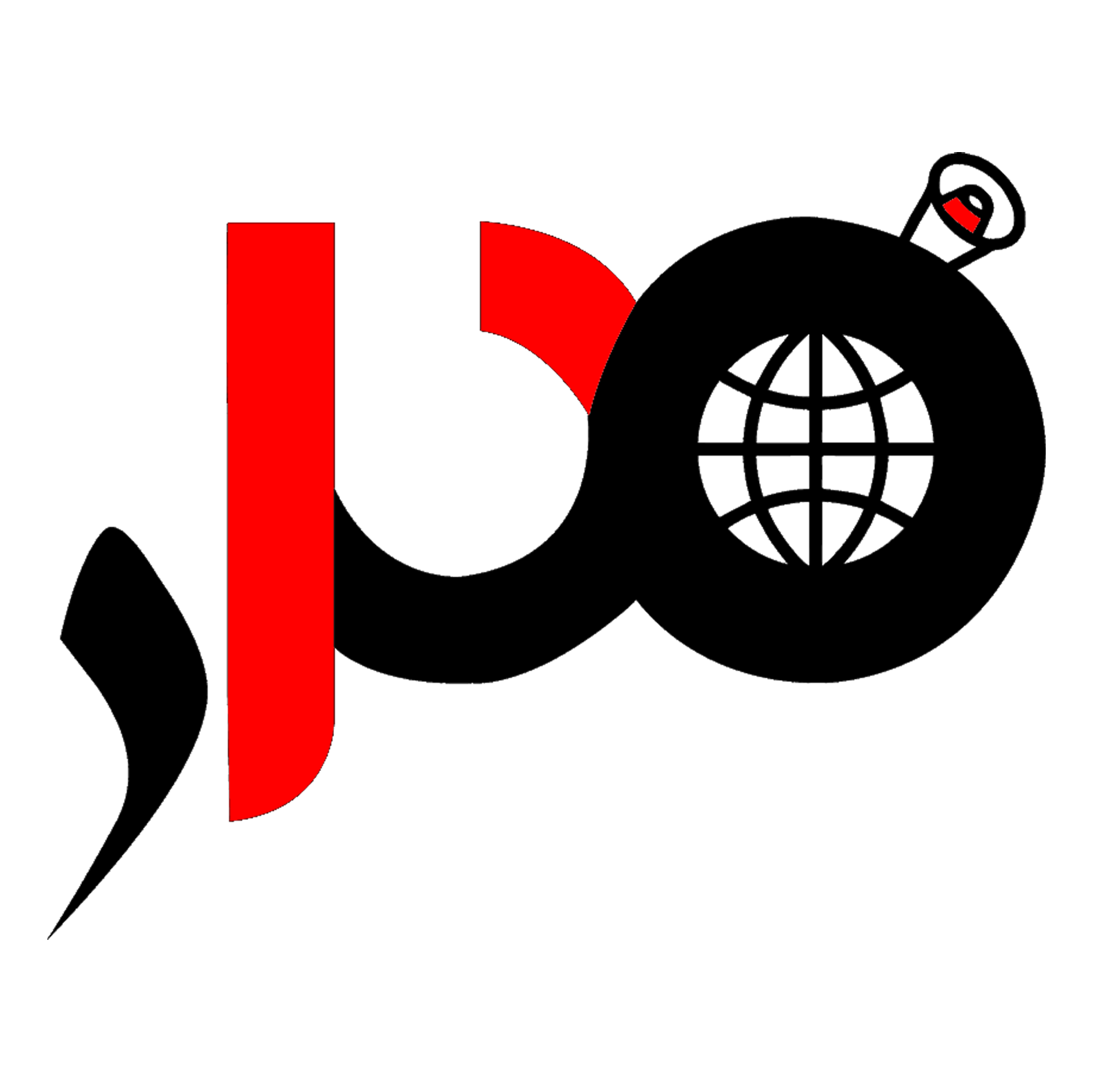مدار: 17 أيار/ مارس 2021
لم ينتظر الحكم في مصر كثيرا حتى غيّر معالم ميدان التحرير، فالساحة الواسعة كانت القلب النابض لملايين المصريين حين خرجوا، قبل عقد، صادحين بصوت واحد: “الشعب يريد إسقاط النظام”. الآن تجثم على قلب القاهرة مسلّة رمسيسية وأربعة تماثيل فرعونية نصبت على قاعدة إسمنتية بشعة.. مشهد يختزل قصة حلم شعب لم تنته بعد.

ويحمل الميدان الكثير من الرمزية، لا يمكن الوقوف وسطه دون الشعور بثقل تلك الذاّكرة الثورية التي هزّت عواصم العالم، وملاحم رسمها الشعب المصري لمّا هدم جدار الخوف وطالب نظام حسني مبارك بالتنحي عن الحكم. كان ذلك قبل عشر سنوات من الآن، وتحديدا يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2011.
وحكم حسني مبارك لثلاثة عقود الجمهورية المصرية.. لم يكفه ذلك، وبعد أن كلّ منه الحجر والبشر، بدأ يفكر في توريث منصبه لابنه جمال، لكن رياح الرّبيع هبّت على أرض الكنانة فكان ميدان التحرير ساحة معركة حقيقية، بعدما حاول النظام مرارا ثني المحتجين عن الخروج إلى الشوارع، وقطع وسائل التواصل؛ لكن ذلك لم يكن عائقا أمام الثوار.
وشكل قمع الشرطة، واستخدام من عرفوا بـ”البلطجية”، الأدوات الأساسية لحكم مبارك في محاولات يائسة لقمع الشعب. وكانت “موقعة الجمل”، التي حاولت خلالها فرق “البلطجية”، محملة على الأحصنة والإبل والعربات، تشتيت المواطنين المعتصمين في الميدان. لكن عزيمة الشباب المنتفض أفشل المخطط، لتنتقل الثورة إلى مستوى آخر.
ورغم محاولات النظام استدراك الأوضاع بتقديم وعود بإصلاحات دستورية وإصلاحات سياسية وحقوقية، وتغيير وزير الداخلية، وعودة خدمات الإنترنت والرسائل القصيرة، التي كانت قد أوقفت مسبقا، إلا أن الجموع الثائرة أكدت مرة أخرى مطلبها الواضح: “إسقاط النظام”.
ولم تخل مناورات الحكم المتداعي من أعمال استهدفت استقرار مصر، مثل إطلاق العنان للمجرمين المدانين، وتحريك الأموال لشراء الذمم، واستهداف النشطاء والصحافيين.
وقدمت الثورة “شهداء” يقدرون بـ 846، وفق إحصائيات أعلنتها هيئة لتقصي الحقائق، كان النصيب الأوفر منهم في القاهرة؛ رغم أن الإحصائيات الرسمية تحدثت عن 384 قتيلا. أما الإصابات فقدرت بالآلاف.. ورغم ذلك ثبت الشعب في الميدان.
ويوم الـ 11 من شباط/ فبراير 2011 أزهرت الثورة نهاية حقبة مظلمة من تاريخ الشعب المصري، لتكتب صحيفة الأهرام بالخط العريض على صفحتها الأولى: “الشعب أسقط النظام”.. كان خبرا زائفا.

وحملت السّفينة حركة الإخوان المسلمين، الذين انخرطوا بحماس في الثورة، إلى سدّة السلطة، بعد مشاركة شعبية غفيرة في الانتخابات الرئاسية الأولى، تحت مظلّة العقد الجديد. وظفر محمد مرسي برئاسة البلاد.. كان الميدان شاهدا على ذلك، وعلى أرضه أقسم الرئيس الجديد رمزيا أمام آلاف المصريين، وهتف: “ثوار أحرار سنكمل المشوار”. لكن السلطان الإسلامي الجديد أغرته نشوة السلطة فاعتقد أنه آن الأوان للمشي بخطى حثيثة نحو إيقاظ حلم الأجداد، فبدأ إجراءات أسلمة الدولة من فوق.
ولم يكن حشو الدولة المصرية اليعقوبية تاريخيا بالعناصر الإسلامية يمر دون أن تلاحظ الدولة العميقة ذلك، ولم تكن أعين الجيش مغمّضة. وكان الانفتاح السياسي والحقوقي فرصة للجيران ليسارعوا نحو وضع أصابعهم في أي مكان استطاعوا إليه سبيلا، فكانت قطر تشّجع مرسي العيّاط على برامجه، كذلك حال تركيا، التي اعتقدت أنها أخيرا ستبني حلفا مع أقوى دولة عربية في شمال إفريقيا، لإحكام الطوق على الشّرق الأوسط.

وفي المقابل، كان الجيش الأداة التاريخية الأكثر فعالية لهدم مشروع التغيير الديمقراطي الذي ثار من أجله الشعب المصري، هو الوحيد المؤهل لإرضاء الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وفي الآن نفسه إحكام السيطرة على جهاز الدولة، التي كان متغلغلا فيها بالفعل؛ فمصر نموذج بارز لبروز أنظمة الحكم المترتبة عن انقلابات عسكرية.. من ثورة “الضباط الأحرار” إلى السادات، ثم مبارك كل الرؤساء السابقين هم سلّان العسكر.
ومنذ بواكر الثورة حرص الجيش على أن يكون صاحب القرار، ونظم نفسه في القيادة تحت مظلّة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يقوده المشير حسين الطنطاوي، وبعد مخاض عسير، راح ضحيّته الآلاف، تسلّم المدنيون السلطة. ولاحقا أقال مرسي الطنطاوي، وعيّن خلفا له عبد الفتاح السيسي سنة 2012.
وبعد عام، كانت مصر قد وصلت فعلا إلى حافة الهاوية، فلا الإخوان باشروا فعلا تحقيق أهداف الثورة، ولا الأوضاع الاجتماعية التي ثار ضدّها المصريون قد تغيّرت، وبدأت الأزمة الاقتصادية ترخي بثقلها على الفقراء والمهمشين، وغاب الاستقرار الأمني، وبدأت القناعات تتشكل بأنه آن الأوان لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وفي الثلاثين من حزيران/يونيو 2013، كانت حركة “تمرّد” جمعت فعلا ملايين التوقيعات الداعية إلى تنحية حكم الإخوان، وبينما لم تكن هناك قيادة سياسية للحراك الثوري، كانت أجهزة الأمن والجيش تتربص. في ذلك اليوم خرج الملايين إلى الشوارع، ليكون ميدان التحرير شاهدا وشهيدا على الحدث المهيب، فتقّدم الجيش ليعلن عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا، ويحكم، من جديد، يده على هرم السلطة، في 03 تمّوز/ يوليوز من السنة ذاتها.. لقد اعتقل مرسي (مات في السجن بعد ذلك) وأرسيت أركان انقلاب عسكري سيجر المآسي والويلات على أم الدنيا.
ووسط العاصمة القاهرة كان الإخوان المسلمون وأنصارهم يرابطون في ساحة رابعة العدوية، رافضين الانقلاب على رئيسهم، ومتشبثين حتى الرمق الأخير بخيارات الحركة الإسلامية، في آخر طلقة بقيت في جعبتهم للمناورة؛ كذلك الحال في ميدان النهضة بمدينة الجيزة. لكن الجيش طلب ما أسماه التفويض لمواجهة الإرهاب، كان يمهد لواحدة من “أكبر المجاز التي عاشتها مصر في تاريخها الحديث”، حسب منظمات حقوقية.

ووصفت منظمة العفو الدولية أحداث فض الاعتصامين بالنهضة ورابعة العدوية يوم 14 أغسطس/ غشت 2013 بـ “الدموية”، إذ قتل ما لا يقل عن 900 شخص، وذكرت في تقرير أصدرته سنة 2019 أن أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاماً صدرت في حق أكثر من 650 شخصاً شاركوا في الاعتصام، كما صدرت أحكام بالإعدام في حق 75 آخرين بعد محاكمة جماعية افتقرت بشدة للنزاهة. لقد شكّلت حجّة “مواجهة الإرهاب الإخواني” أداة مركزية في قمع حريات المصريين.
وبعد عقد على الثورة، تحوّلت مصر إلى سجن كبير، وأصبح التعبير عن الرأي جريمة قد تؤدي بالمعارضين إلى السجن لعشرات السنوات. سنة 2019 اعتقل النظام المصري أكثر من 1500 متظاهر في أقل من أسبوع، فقط لأنهم خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من الفقر والتهميش. واعتبر الاشتراكيون الثوريون حينها أن “كراهية هذا النظام تزداد يومًا بعد يوم”، فسطوة السيسي تطال المعارضة كلها، من “اضطهاد وملاحقة” تضيف الحركة اليسارية المعارضة.
وامتلأت السجون بالمعارضين، إسلاميين كانوا أم غيرهم، ولم يسلم أحد، من إعلاميين وسياسيين ومدافعين عن حقوق الفقراء والمهمشين. أما من أسعفهم الحظ للفرار نحو الخارج فإن عائلاتهم مهدّدة باستمرار، إذ تقوم الداخلية المصرية باعتقال وتهديد أسر المعارضين الذين ينشطون في الخارج، حسب تقارير حقوقية.

وملأ النظام السياسي، الذي استقر على هرم السلطة بعد “الانقلاب العسكري” سنة 2013، السجون بأكثر من 60 ألف سجين سياسي، حسب تقارير حقوقية وإعلامية. لكن الأرقام الحقيقية غير معروفة، لأن السلطات المصرية تفرض تعتيما شديدا حول الموضوع.
وجاءت جائحة كورونا لتفضح الأوضاع الخطيرة داخل السجون المصرية، من الاكتظاظ إلى التعذيب والإهمال الطبي. وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث: “تعاني السجون في مصر منذ زمن طويل من ظروف الاحتجاز غير الإنسانية، التي تؤثِّر سلباً على تمتُّع السجناء بحقهم في الصحة”، وأوضحت أن المخاطر “تتزايد على صحة السجناء وأرواحهم جراء تقاعس سلطات السجون، سواء من خلال الإهمال أو الحرمان المتعمَّد، عن توفير الرعاية الصحية الكافية للمحتجزين لديها، ما يمثل مخالفةً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وتتفاقم الأوضاع الاجتماعية المزرية للمصريين يوما بعد يوم، لكن السلطات المصرية منشغلة بإنجاز مشاريع تصفها بـ”الإستراتيجية”، مثل مشروع القطار السريع، والمحطة النووية، وتوسيع قناة السويس، وبناء المدينة الإدارية الجديدة. وكلف ذلك ميزانية الدولة ملايير الدولارات.
وبينما يواجه ملايين المصريون آفات الفقر والجوع تختبئ الحكومة وراء الديون الخارجية، ويدق اختصاصيون ناقوس الخطر من انهيار شامل للاقتصاد.
“الدولة لجأت إلى طريقة للسداد أعترض عليها وأحذر منها كثيرًا، هي أخذ ديون جديدة لسداد ديون قديمة، وهي عملية نصب، لو توقف آخر مقرض ستنفرط السلسلة وهو أمر يتم فجأة دون أن تدري وسيؤدي إلى انفجار، بمعنى أنك ستتوقف عن سداد الديون رغما عنك، وتصبح مصر دولة مفلسة”، يقول محمود وهبة، أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال المصري في تصريح إعلامي، وزاد: “عند حسابي للدين الخارجي لمصر أجد أنه وصل إلى نحو 230 مليار دولار، وذلك بإضافة تكلفة إقامة محطة الضبعة النووية بقيمة 32 مليار دولار والقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار. ونحن الآن في شهر فبراير/ شباط والدولة لا تتوقف عن الاقتراض”.
وكانت الثورة المصرية فرصة ليزهر طموح الشباب، فانفجر إبداعا فنيا وثقافيا وسط لحظة خاطفة من نسيم الحرية، كان ثمنها باهظا، من حياة من سقطوا أو سجنوا في سبيل الحلم الذي لم تنته قصته بعد. ولم يكن خطأ أن يثور الشعب من أجل مستقبله، رغم أن الإعلام المصري، الذي أحكمت المخابرات العسكرية الطوق عليه، ينفث سمه المجرّم للنضال، وترسم أرض الكنانة جنة والسيسي زعيما مخلّصا، في حين أنها لا تعدو أن تكون قرية بوتيمكين. وفي ظل الغليان الشعبي فإن الثورة من دروس التاريخ تنبعث من حيث لا يدري الاستبداد.
لا توجد كلمات تستطيع أن تعبر عما يعنيه ميدان التحرير، وما تحمله صورته في أذهان الناس من ثقل سياسي وإنساني، ورغم ذلك تتسلل إلى الذهن كلمات يخطها شباب مصر، فينزل الدمع على خدود من آمنوا بالحلم. كذلك فعل أمير عيد حين كتب “الميدان”، وغنتها كايروكي وعايدة الأيوبي..
ياه يا الميدان.. كنت فين من زمان
معاك حسينا وابتدينا.. بعد ما بعدنا وانتهينا
لازم بإيدينا نغير نفسينا.. اديتنا كتير والباقي علينا
ساعات بخاف تبقى ذكرى.. نبعد عنك تموت الفكرة
ونرجع تاني ننسى اللي فات