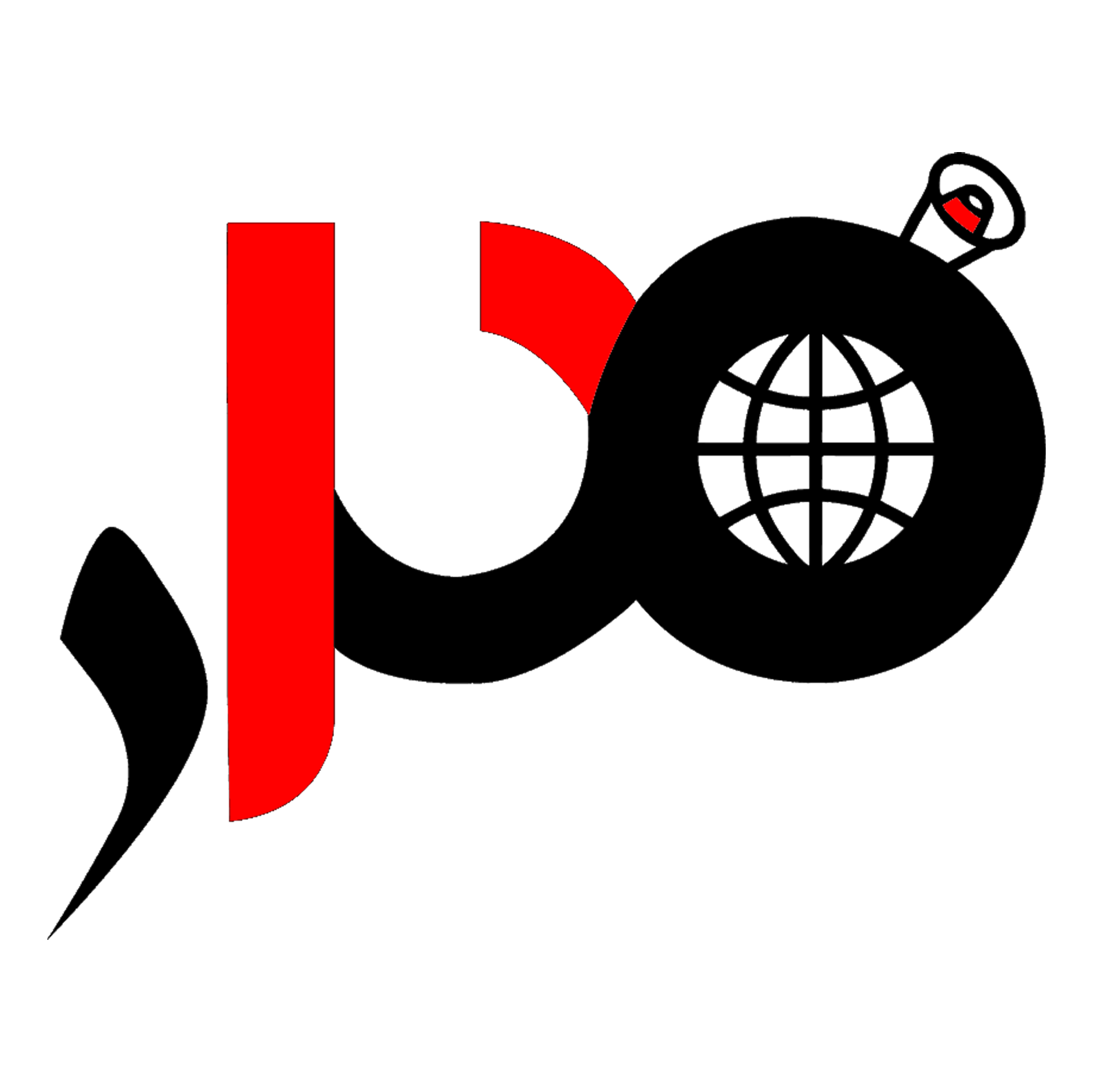صورة: DR
مدار: 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
تحققت العلمانية في أوروبا بعد صراع مرير دام من القرن 16 إلى القرن 18 بين فكر التنوير والظلامية المتلفعة بالدين، واكتست في فرنسا طابعا جذريا مع الثورة الفرنسية 1789، إذ تميز التنوير الفرنسي بعدم التصالح مع رجال الدين على غرار ما وقع من توافقات في ألمانيا وبريطانيا.
وهكذا استقر تعريف العلمانية على أنها مبادئ تتعلق بحضور الدين في المجتمع، بحيث تقر التشريعات بفصل السلطة السياسية عن التنظيمات والمؤسسات الدينية، ويقر الدستور بحياد الجمهورية تجاه الشأن الديني، ويضمن حرية التعبد، ما دام ممارسوه يحترمون الفضاء العام، كما يعلن حرية الضمير ويؤمن تعدد الآراء السياسية، وتلخصه الصيغة الواردة في فصله: “الجمهورية لا تعترف ولا تدفع أجرا ولا تدعم أي شعيرة دينية”. ولا تعني العلمانية في سياق هذا الحياد أن تقاوم السلطات العمومية الأديان، ولكن أن تمنع تأثيرها على السلطة السياسية والإدارية.
هذا المبدأ الذي تحول إلى تقليد راسخ في المؤسسات والمعيش اليومي للفرنسيين غير جذريا المجتمع الفرنسي، إذ منع سيطرة طائفة دينية على المجتمع، بضمان حياد الدولة، وحصر الشأن الديني في المجال الخاص، إذ منع دستور 1905 أي دور سياسي للطوائف الدينية بالتنصيص على الطابع القابل للتجزئة والعلماني للجمهورية.
غير أن المبدأ الدستوري لم يحافظ على نقائه وهو يختلط بطين التاريخ، فمع غزو فرنسا للجزائر سنة 1830، بدا الحضور الكولونيالي الفرنسي في البلدان المسلمة، خصوصا في الجزائر وتونس والمغرب، ثم جرت استضافة سكان تلك البلدان في المتروبول لدواعي لا تتعلق بالكرم الفرنسي؛ ففرنسا كانت بحاجة ماسة إلى يد عاملة مستعدة لتحمل مشقات العمل مقابل أجر زهيد.
ولم يكن أمر الهجرة المغاربية يتعلق في بداية القرن إلا بآلاف الأفراد باهتي الحضور في المجتمع الفرنسي، ولكن مع اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914 نقلت فرنسا ست مائة ألف رجل بينهم “الكومي” les goumis المغاربة، وأيضا قسم كبير من الجزائريين، قدرتهم بعض الإحصائيات بثلث الذكور المتراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين. ولم يقتصر الحضور المسلم على الجندية، بل عمل بعضهم في المصانع المسيرة من طرف العسكر.
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، وبروز الحاجة الملحة لإعادة البناء، كان ضروريا أن تستعين فرنسا بسكان شمال إفريقيا، فكانت هجرة كثيفة للمغاربيين الباحثين عن فرص عمل وتحسين وضعهم المعيشي، وهم يشكلون الآن أغلبية مسلمي فرنسا. لكن وجود المهاجرين لم يتجاوز الأرقام، ولم يتحول إلى “ظاهرة” للعيان وإلى مشكلة التكيف مع بيئة جديدة. لم يكن يوجد في بداية السبعينيات أكثر من حوالي 10 مساجد وقاعات عبادة، مع أن فئة سكانية هامة من أصل إسلامي كانت تقيم في هذا البلد، لكنها كانت تعبر عن انتمائها الديني هامشيا وتمارس طقوسها الدينية دون ظهور علني، قبل أن يزداد ظهور المساجد التي تتجاوز عددها الألف مسجد ومكان للعبادة، حسب ما أحصاه جيل كيبيل في كتابه “ضواحي الإسلام”.
لكن انتعاش الإسلام السياسي في الجزائر، مضافا إلى الثورة الإيرانية، مد إسلام الضواحي في فرنسا بأسباب القوة، ما برز بشكل عنيف في الأحداث الإرهابية التي عرفتها باريس، والتي كانت وراءها الجماعة الإسلامية المقاتلة سنة 1990.
ومع هذا التحول الذي جرى داخل المجتمع الفرنسي كان طبيعيا أن تجد العلمانية الفرنسية نفسها أمام إشكاليات جديدة، وكان عليها أن تخضع لعقاب الديموغرافيا التي جعلت الفرنسيين ذوي الأصول المغاربية والمسلمين عموما حاضرين عدديا، وأصبحوا يطالبون بتحول الكم إلى معنى لا يتحقق في إدراك الكثيرين إلا باستدعاء الهوية، حين لا يستطيع المهاجر تحقيق “العيش المشترك” في المدرسة، وحين الاستفادة من الصحة العمومية وتلقي العلاجات الطبية، وحين تطبيق المراسيم الجمهورية، وهي الإشكاليات التي وجدها الإسلام الوهابي المدعوم سعوديا فرصة لموطئ قدم في “أرض الهجرة”.
أما فرنسيا، فتفاوت التعامل بين من لا يتذكر المهاجرين إلا مع موعد اقتراب الانتخابات، وبين من لا يرى في المهاجر إلا بروليتاريا تحرر كليا من كل “بقايا المجتمعات السابقة” وانخرط في الصراع الكوني، فبأهداف انتخابية حاول الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي كسب أصوات الناخبين المسلمين منذ السبعينيات. وفي العشرية الماضية من القرن الحالي طفت خلافات بين عموم اليسار، بين من ينادي بعلمانية صارمة على غرار ما سنه دستور 1905، ومن يسعى إلى صيغة مصالحة تولي أهمية للقضايا الاجتماعية أكثر من القضايا الدينية، وطرف ثالث وضع الإسلاموفوبيا في مركز اهتمامه محاولا الحد من انتشارها، منتقدا وصم الحجاب بالرجعية وربطه بالتخلف. أما اليمين الفرنسي فتلخص موقفه زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبين التي سبق أن قارنت صلاة المسلمين في الشوارع بالاحتلال سنة 2010.
رسميا، أقدمت فرنسا منذ 2003 على خلق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أجل إيجاد محاور مع الفرنسيين الذين يمارسون الشعائر الإسلامية، لاحتواء الظاهرة ومواجهة “التطرف الإسلامي”، وفي 10 شباط/ فبراير 2004 صادق المجلس الوطني على قانون يمنع استعمال الرموز الدينية، وهو القانون الذي اقترحه جاك شيراك في كانون الأول/دجنبر 2003. كما سنت في 11 كانون الأول/ دجنبر 2010 القانون رقم 2010-1197 الذي يمنع حجب الوجه، حيث نص على التالي: “لا يحق لأي كان أن يرتدي زيا يحجب وجهه في الفضاء العام”.
هكذا جاءت قرارات ماكرون ممثل وسط اليمين غير خارجة عن سياق علمانية فرنسية تعلي من شأن مبادئ الجمهورية، لكنه يوظف المبادئ وعينه على الاستمرار في كرسي الرئاسة، دون أن يلتفت لظرف دولي يركب فيه رجب أردوغان موجة الإسلام السياسي لاستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، وتدغدغ الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي مشاعر الجمهور العريض للحفاظ على الوضع القائم.
إن المسلم الفرنسي في “دار الهجرة”، وهو يعيش العنصرية والاحتقار، ويكتشف الفارق الكبير بين البلد الفردوس الذي حلم به والبلد الذي أفنى عمره من أجل إعادة بنائه بعد خراب العالمية الثانية، لا يجد ملاذا إلا في الدين واستعادة هدوء قريته الضائعة هناك وراء البحر، وفي هذا الوضع المأزوم يستعيد ذكريات استعمار فرنسي سرق الأرض وشرد سكانها، وتأكله الحيرة في أسئلة لا يقدم اليمين الفرنسي أجوبة لها، فهل يجد اليسار الجواب المطلوب بصياغة علمانية جديدة تتفاعل مع التحول المجتمعي؟.