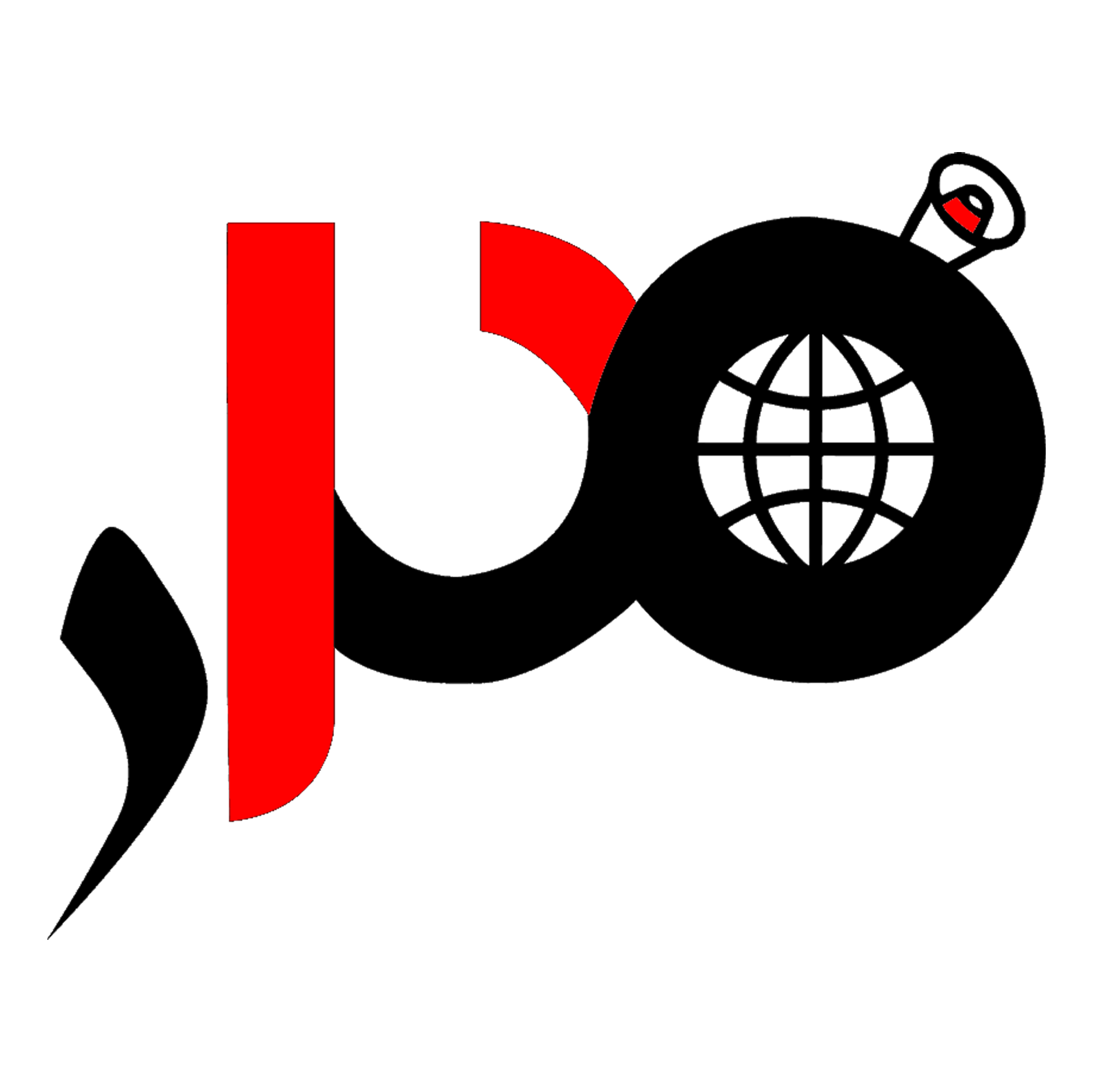معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي/ مدار: 18 أيلول/ سبتمبر 2025
فيجاي براشاد
صورة الواجهة: جيلاسيو جيمينيز باريرا (كوبي هندوراس)، (بدون عنوان)، 1986.
عند ضريح برتا إيزابيل كاسيريس فلوريس (1971-2016) في لا إسبيرانزا، هندوراس، حيث وُلدت وماتت، رأيت فراشة صفراء تتراقص حول شجيرة الجهنمية (Bougainvillea). طارت كأنها لا تبالي، متنقلة من جدث إلى جدث في المقبرة الهادئة. بجوار ضريح برتا يرقد شقيقها، كارلوس ألبيرتو لوبيز فلوريس (1958-2004)، شيوعي درس في جامعة باتريس لومومبا بموسكو، وكان له تأثير حيوي على فكر أخته الصغرى. الجانب الآخر لضريح برتا لا يزال فارغاً، ينتظر جثمان والدة كارلوس وبرتا، ماريا أوسترا برتا فلوريس لوبيز – المعروفة باسم ماما برتا – التي دَفنت اثنين من أبنائها. حامت الفراشة الصفراء فوق ضريح برتا، حيث كانت أزهار جديدة تركها زوار، مثلنا، أتوا لتقديم احترامهم لهذه المناضلة الأسطورية التي قُتلت دفاعاً عن حقوق شعب اللينكا في هندوراس، وعن النضال الأممي من أجل العدالة الاجتماعية.

لقد زرت قبوراً ونُصباً تذكارية كهذه في جميع أنحاء العالم: النصب التذكاري لـ “ليندوكوهلي منغوني” (1994-2022)، الشاب الذي ترأس كوميونة إيكينانا وقائد حركة سكان الأكواخ “أباهلالي باسي مجوندولو“، الذي اغتيل في منزله بديربان، جنوب أفريقيا، والذي كان يكتب بانتظام ردوداً على هذه المراسلات؛ والنصب التذكاري لـ “غوري لانكيش” (1962-2017)، التي أُرديت قتيلة عند باب منزلها في بنغالورو، الهند، على أيدي بلطجية من لواء هندوتفا اليميني المتطرف بسبب عملها الشجاع كصحافية ذات ضمير؛ وقبر “شكري بلعيد” (1964-2013) في مقبرة الجلاز بتونس، حيث اغتيل خارج منزله في لحظة كان فيها – كقائد نقابي – على وشك الدفع نحو حكومة علمانية في تونس. وهناك قبور ونصب من سنوات أقدم لا تزال تشدّني: قبر “فيكتور خارا” (1932-1973)، الذي عُذّب وقُتل على أيدي زبانية بينوشيه بعد الانقلاب، في المقبرة العامة في ريكوليتا قرب منزلي بسانتياغو، تشيلي؛ ومكتب “مهدي عامل” (1936-1987)، الذي أبقته زوجته إيفلين برون حمدان (1937-2020) كما تركه تماماً عندما نزل ليأخذ بنطالاً من المصبغة واغتيل بسبب انتقاداته الماركسية للطائفية الدينية؛ والنصب التذكاري لـ “كريس هاني” (1942-1993)، الشيوعي الجنوب أفريقي العظيم، الذي اغتيل عندما بدأت جنوب أفريقيا انتقالها من الفصل العنصري، بالضبط عندما كان هو – صوت الطبقة العاملة في بلاده – سيضفي حساً بروليتارياً على الحكومة الجديدة.
لماذا قُتل هؤلاء الناس؟ وماذا كان ذنبهم؟ لقد آمن كل منهم – بطرق مختلفة – بضرورة توسيع الآفاق من أجل الكرامة الإنسانية في العالم. كتب فيكتور في “مانيفستو” – أغنيته الأخيرة التي أصدرتها زوجته جوان خارا (1927-2023) بعد وفاته – مع وعي بمدى صعوبة بناء الاشتراكية من خلال البنى الرأسمالية، والعنف الذي ستلجأ إليه النخب للاحتفاظ بسلطتها:
غيتار عامل،
بعطر الربيع.
ليس هو غيتار رجل ثري،
ولا يشبهه بشيء.
أغنيتي تأتي من أعواد المشانق،
لتبلغ النجوم.
لم يتمن أي من هؤلاء شراً للعالم. ناضلت برتا في سبيل حقوق الناس العاديين في تقرير كيفية تكريس مواردهم من أجل تقدمهم؛ وناضل ليندوكوهلي من أجل حق الطبقة العاملة بجنوب أفريقيا في العيش في مسكن لائق والتحكم في مصيرها؛ وناضلت غوري من أجل حق الشعب الهندي في التفكير ومعرفة الحقيقة.

المسلحون الذين قتلوهم فعلوا ذلك من أجل المال. كان معظمهم قتلة مأجورين، تروساً في آلة هائلة من الربح والموت. غالباً ما يكون القتلة المأجورون هم من يُقبض عليهم في التحقيقات، يُتهمون ويُسجنون. أما أولئك الذين وضعوا السلاح في أيديهم ووجهوا فوهته نحو من حُكم عليهم بالموت، فهم غالباً ما يكونون غير مرئيين، بلا تهمة، وذوي سطوة. يدّعون البراءة. أيديهم نظيفة، لا بارود على أصابعهم، ولا دماء على أحذيتهم. من قتل برتا؟ هل هم الرجال الذين اعتقلوا واتهموا، أم شخصيات أخطر – أصحاب ممتلكات تعطلت خططهم لتحقيق المزيد من الأرباح في مرتفعات اللينكا بفعل برتا ومجلس الهيئات الشعبية والأصلية في هندوراس (COPINH)؟ ربما جاء قتلة بلعيد من أحياء تونس الفقيرة مثل حي التضامن (في العاصمة التونسية)، لكن القتلة الحقيقيين دبروا مؤامراتهم في فيلات فاخرة على “ضفاف البحيرة”، كما كتبنا في ملف نشر بشكل مشترك مع “مجلس الهيئات الشعبية والأصلية في هندوراس”.
قبل عام من مقتله، التقيت شكري بلعيد في تونس، حيث أمتعني بقصص الكفاح للإطاحة بحكومة زين العابدين بن علي. كان يتحدث عن النضال والمستقبل بأسلوب بديع، حس شاعري حمله معه من شبابه وأيامه كطالب في بغداد. طوال حياته، كتب قصائد عن الحرية، جمعتها عائلته ونشرتها بعد وفاته تحت عنوان “أشعار نقشتها الريح على أبواب تونس السبعة”. إحدى هذه القصائد، التي كُتبت على الأرجح في ذروة القمع السياسي في أواخر الثمانينيات، بعنوان “لا تطردوني”:
لا تطردوني
أنا الوقت في وقتكم مذبحة.
أنا وجع أو نشيد قديم.
أنا لعنة قادمة.
كان بلعيد يتوق إلى الجمال. تخبرني ابنة برتا، المعروفة بـ “برتيتا” – أن أمها كانت تحب الفرح (وقليلاً من التيكيلا). كانت غوري تحب الطبخ وتستمتع بموسيقى الروك آند رول. كان ليندوكوهلي قارئاً نهماً، يلتهم فرانز فانون وستيف بيكو وكذلك “البيان الشيوعي”. لا يستطيع القتلة ومن دفعوا لهم محو الإنسانية العميقة لهؤلاء القادة في حركاتنا. لقد قتلوهم لأن الحركات وقادتها “لعنة قادمة”، يناضلون من أجل الخروج من عالم الربح والعنف لبناء عالم من الكرامة والإنسانية المشتركة.

عند ضريح برتا، وبينما تتصاعد إبادة إسرائيل في غزة وأُعلنت المجاعة، أفكر في باسل الأعرج (1984-2017)، الذي التقيته في رام الله قبل سنوات من مقتله على أيدي الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وجّه باسل عقله النيّر إلى الكتب والأفكار، بانيًا جسداً من الفكر حول الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، مما جعله في نظري غسان كنفاني هذا الجيل (1936-1972)، المفكر الشيوعي الفلسطيني العظيم الذي قتلته سيارة مفخخة إسرائيلية مع ابنة أخته لميس نجم البالغة من العمر سبعة عشر عاماً في بيروت، لبنان. في فيديو موسيقي لفرقة “ميماس” من غزة، صدر بعد وفاة باسل، يظهر في نهايته متحدثاً عن أهمية أن يكون المرء مثقفاً مشتبكاً (كتب مغني الفرقة، حيدر عيد، كتاب “الطرق على جدران الدبابة: رسائل من غزة”، الذي صدر للتو عن دار نشر “إنكاني” في جوهانسبرغ): يقول باسل: “إن لم تكن مثقفًا مشتبكًا فلا منك ولا من ثقافتك”. عندما قُتل، كان بجانبه كتابان – أحدهما للماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي والآخر للشيوعي اللبناني مهدي عامل.
عند ضريح برتا، قرأت جزءاً من “رماد غرامشي” لبيير باولو بازوليني (1954)، حيث يزور قبر غرامشي ثم يغادر إلى العالم الذي يتجاوز المقبرة:
سأذهب ، أتركك في المساء
الذي ، رغم كآبته ، يهبط عذبا
علينا نحن الأحياء ، بنوره الشّمعي
الذي ينكمش في الحيّ في شبه الظّل.
يهيّجه ، يجعله أكثر اتساعا ، فارغ الجنبات ،
ويبعث فيه عن بعدٍ حيوية الحياة التي تعزف،
من خلال دورة الترام وصرخات البشر
الشّعبية ، لحنا مطلقا وضعيف.
وتشعر كيف أن الحياة لدى
تلك المخلوقات البعيدة التي
تصرخ وتضحك بسيّاراتها
ومنازلها التّعيسة ، حيثُ تُستَهلك
هبة الوجود الغادرة والمنفتحة ـ
تشعر أن تلك الحياة ليست سوى رعشـة ؛
حضور جسدي وجماعي ؛
وتشعر بفقدان كلّ دين ؛
إنها ليست حياة ، بل عيشاً على هامش الحياة
قد يكون أكثر سعادة من الحياة ذاتها ـ
مثل جمهرة من الحيوانات التي يكون
ولعها ولذتها السّرية في نشاطها
اليومي فقط : هذا الحماس المتواضع
الذي يستمد معناه الاحتفالي
من الفساد المتواضع.
…
إن الحياة همهمة ، أما هؤلاء الضّائعون فيها
فيفقدونها بسكينة ، وقلوبهم تطفح بها :
وهاهم ، فقراء ، يتمتعون بالحياة : عُزَّل ،
تولد الأسطورة فيهم ومن أجلهم… ولكني ،
بقلب مَن يعي أن الحياة هي في التّاريخ فقط ،
أيمكنني أن أسعى بكل هذا الشّغف وأنا
أعلم أن لتاريخنا خاتمة ؟
لكن تاريخنا، كما أدركت برتا، لا ينتهي بهذه السهولة. نضالاتنا حيوية وضرورية، وعدواها، كما عرف باسل، تنتقل.