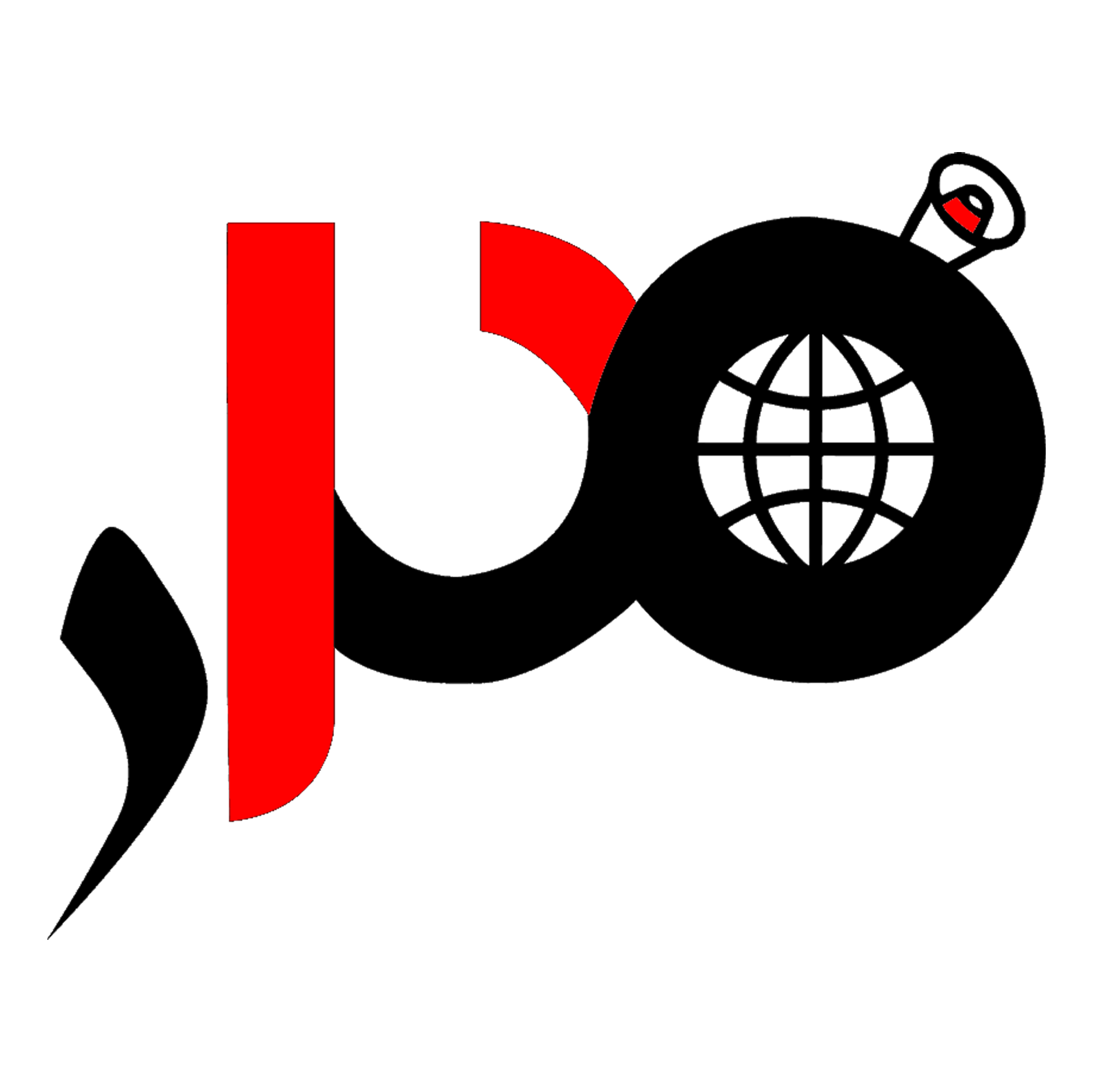مدار: 22 آذار/ مارس 2021
اشتعل فتيل الحراك الشعبي بالجزائر مطلع سنة 2011 متأثرا بشكل غير مباشر بتراكمات سياسية وسوسيو-اقتصادية تعيشها البلاد منذ سنوات، رغم ثرواتها النفطية التي تجعلها بلدا غنيا وشعبا مفقرا. بينما شكل اندلاع الثورة التونسية والمصرية وانتشار الاحتجاجات بأغلب البلدان المغاربية والعربية أحد الأسباب المباشرة لذلك.
وغير آبهين بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ سنة 1992، خرج الجزائريون يوم الأربعاء 05 يناير 2011 للشوارع والساحات بعدة مدن احتجاجا على الغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، كالدقيق والزيت والسكر وتفشي البطالة وسط كل الفئات الشعبية، وأزمة السكن. أو على الأقل هذا ما حاول النظام الجزائري ترويجه ساعتها، مخفيا الأسباب السياسية والدوافع الحقيقية التي جعلت الشعب الجزائري ينتفض في وجه الظلم و”الحكرة”، حسب التعبير الذي جاء في تصريح الدكتور ‘صلاح الدين سيدهم’، وهو ناشط حقوقي جزائري، لقناة الجزيرة بتاريخ 13 يناير 2011، والذي حاول من خلاله أن يوضح أن انسداد الأفق السياسي بالجزائر بعد أن كان نظام بوتفليقة قد أحكم قبضته عليه هو الدافع الحقيقي وراء الاحتجاجات، موضحا أن القضية في الجزائر هي قضية سياسية مرتبطة بشرعية النظام القائم، وليست قضية اجتماعية أو انتفاضة جوع مرتبطة بمطالب خبزية كما يروج لها أبواق النظام، حسب تعبيره، واصفا إياها بأنها “مغالطة وادعاءات كاذبة”.
ما صب الزيت على النار هو انتشار ما سميت الظاهرة البوعزيزية بالجزائر، تيمنا بالبوعزيزي، الشاب التونسي الذي توفي بعد أن أضرم النار بجسده، وهو الحادث الذي أطلق الشرارة الأولى لاندلاع الثورة التونسية التي أسقطت زين العابدين بنعلي، وامتدت إلى باقي الدول العربية.
وعلى نهج محمد البوعزيزي أقدم محسن بو طرفيف يوم 15 يناير 2011 بولاية تبسة على إضرام النار بجسده، بعد أن رفض رئيس ولاية بوخضرة استقباله ومساعدته في الحصول على عمل يمكنه من إعالة أسرته، ليتوفى بعد ذلك بأيام متأثرا بحروقه. ثم سجلت الجزائر ثاني حالة وفاة حرقا بعد أن قام الشاب كريم بن دين بحرق نفسه يوم 18 يناير 2011 في مدينة دلس بولاية بومرداس، للأسباب نفسها، وهي سوء الظروف المعيشية.
وتوالت حالات إحراق الذات في مختلف البقاع في الجزائر، وفي فترات مختلفة تزامنت مع احتجاجات واسعة وغضب عارم لشباب مطالبين بمحاسبة المسؤولين، ووسط التهديدات بالمزيد من إحراق الذات. ورغم المحاولات التي بذلها النظام لتهدئة الوضع والالتفاف على ملفات ضحايا “الظاهرة البوعزيزية” عبر فتح تحقيقات وإعفاء مسؤولين كبار، كما حدث مع مير بوخضرة في ملف بوطرفيف، الذي عزل مباشرة بعد الحادث.
كما حاولت الحكومة الالتفاف على الحراك وإرضاء الشارع الساخط عبر مجموعة من الإصلاحات، منها تعليق الرسوم الضريبية على بعض المواد الأساسية كالسكر والزيت، ورفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على البلاد منذ 1992. وتحت ضغط الشارع تم التراجع عن العديد من القرارات التي كان النظام قد اتخذها، كالتي تخص الحقل التعليمي بخصوص سلك المهندسين والماجستير. كما كان الرئيس وعد بإصلاحات سياسية تهم قانون الانتخابات والدستور…
إلا أن المقاربة الأمنية القمعية كانت سيدة الموقف، وكانت الجواب الصريح على الحراك، منذ اليوم الأول من الاحتجاجات، إذ تحولت ساحات باب الواد وبلكور وغيرها بالجزائر العاصمة ومدن أخرى، كوهران والجلفة، إلى ميادين لمعارك واشتباكات دامية بين الشرطة والمحتجين، مخلفة مئات الجرحى والمصابين. كما تم اعتقال المئات، وجهت لهم تهم مختلفة، من قبيل إثارة الشغب وتدمير الملك العام وغيرها، وسقط ضحايا أيضا.
وبعد أن كان عبد العزيز بوتفليقة يعتقد أنه أحكم قبضته على نظام الحكم بالجزائر، وأن مقاربته الأمنية نجحت في إخماد نيران الاحتجاجات الشعبية المتأثرة برياح التغيير التي عرفتها المنطقة في 2011، وبعد مرور 8 سنوات من قمع الحريات ومصادرة حرية التعبير ومتابعة النشطاء، قام بتقديم ملف ترشيحه لخوض غمار انتخابات 18 أبريل/نيسان 2019 من أجل ولاية خامسة.
لم يكن بوتفليقة يعلم أن هذا الترشيح سيأتي بنهاية عهده الرئاسي الذي امتد حوالي عشرين عاما؛ ففور تأكيد ترشيحه اتقدت جمرة الاحتجاجات في البلاد من جديد وخرج آلاف المواطنين/ات في الثاني والعشرين من فبراير/شباط 2019، رافعين مطالب سياسية بحتة، وشعارات رافضة لترشيح الرئيس الحاضر الغائب عن وسائل الإعلام منذ 2017 بسبب وضعه الصحي لولاية خامسة؛ كما اعتبروا وجود بوتفليقة وأذياله من المؤسسة العسكرية معرقلا لتحقيق الديمقراطية بالبلاد.
وعلى عكس حراك 2011 لم تُوفق المقاربة الأمنية هذه المرة في إخماد الاحتجاجات، التي ازدادت زخما وتجذرا في مختلف الفئات الشعبية، من نساء وأطفال ومسنين وفاعلين من مختلف الأقطاب السياسية، من إسلاميين ويساريين. كما عرفت الاحتجاجات مشاركة مثقفين وقضاة وباقي شرائح المجتمع.
وأجبرت هذه الاحتجاجات الرئيس السابق بوتفليقة على التنحي عن منصبه في 2 أبريل/نيسان 2019، فأجريت انتخابات رئاسية أفضت إلى فوز الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر/كانون الأول من السنة نفسها؛ وكان قد وعد الشعب الجزائري بالعديد من الإصلاحات الدستورية وإحداث جملة من التغييرات، إلا أن جائحة كورونا كان لها رأي آخر، إذ أجبرت الجميع على التراجع، سواء الحراك وتظاهراته أو المؤسسة الرئاسية وإصلاحتها.
هذه الجائحة جعلت النظام الجديد القديم يفشل في أول اختباراته، إذ زادت إجراءات الحجر الصحي وتداعيات أزمة كورونا الوضع سوءا في الجزائر التي طالما اعتمدت على عائدات النفط والغاز التي لم تكن تضمن الأمن الاقتصادي فحسب، بل كان النظام يعتمد عليها لشراء السلم الاجتماعي عبر دعم المواد الأساسية والسكن…
وشكلت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع قيمة النفط وشل الحركة الاقتصادية في العالم أزمة سياسية للحكومة في الجزائر، إذ لم تعد قادرة ماديا على شراء السلم الاجتماعي كما في السابق.
كما أن كورونا غيبت الرئيس عبد المجيد تبون عن الأنظار بعد إصابته بالفيروس التاجي، ما اضطره للسفر لتلقي العلاج بألمانيا، ما أدى إلى المزيد من الاحتقان وسخط الشعب الذي ظل يعاني الأمرين من تردي الخدمات والمنظومة الصحية، وفيروس بات يفتك به.
ومن تداعيات الجائحة تأجيل جملة من “الإصلاحات” التي كان الرئيس قد وعد بها خلال حملته الانتخابية، من أهمها الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري الذي تم إرجاؤه إلى الأول من نوفمبر /تشرين الثاني، وهو التعديل رفضه الشعب الجزائري، معتبرا أنه لا يرقى إلى مستوى التغيير الجذري الذي كان يسعى له الحراك، ما اعكس بتسجيل نسبة مقاطعة هي الكبرى في تاريخ الجزائر، بمعدل فاق 75 في المائة.
وشكلت الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي الذي أطاح ببوتفليقة مناسبة لكسر القيود التي فرضتها الجائحة، والعودة إلى الشارع مجددا للتأكيد على مطالب الحراك والتمسك بها، وهي العودة التي تم التحضير والتعبئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشهور عبر هاشتاغات وتغريدات تدعو للخروج.
وقد خرج المتظاهرون بشعارات رافضة للدولة العسكرية ومطالبين بدولة مدنية وبتغييرات جذرية تقطع مع النظام السابق الذي يعتبر تبون استمرارية له ولسياساته، كما رفضوا إجراء الانتخابات التشريعية وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين الذين تم التضييق عليهم ومصادرة حقهم في التعبير.
و للإشارة فإنه إلى حدود الأسبوع الأول من مارس /آذار2021 دخل الحراك أسبوعه السادس بعد المائة، وقد أثارت مسألة إسقاط الجنسية سخطا واسعا وسط الشارع الجزائري الذي مازال شيبا وشبابا نساء ورجالا مواصلا الطريق الذي شقه بسلمية منذ عشر سنوات من أجل بناء جزائر جديدة مدنية وليست عسكرية، وتحقيق حرية وديمقراطية حقة ترقى إلى مطامح شعب يكتب التاريخ ويصنع الحدث اليوم.